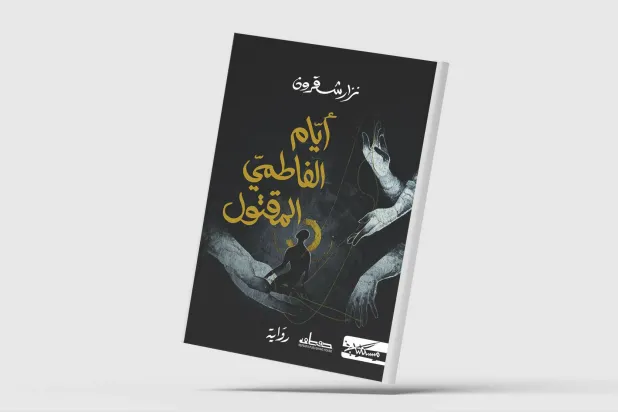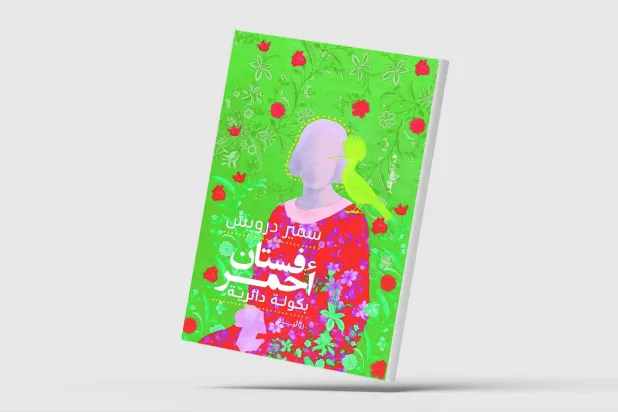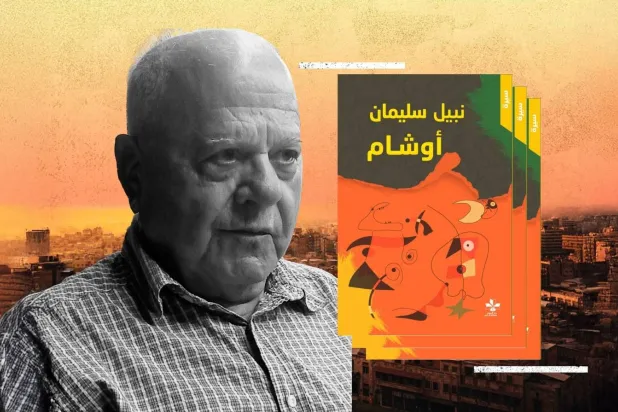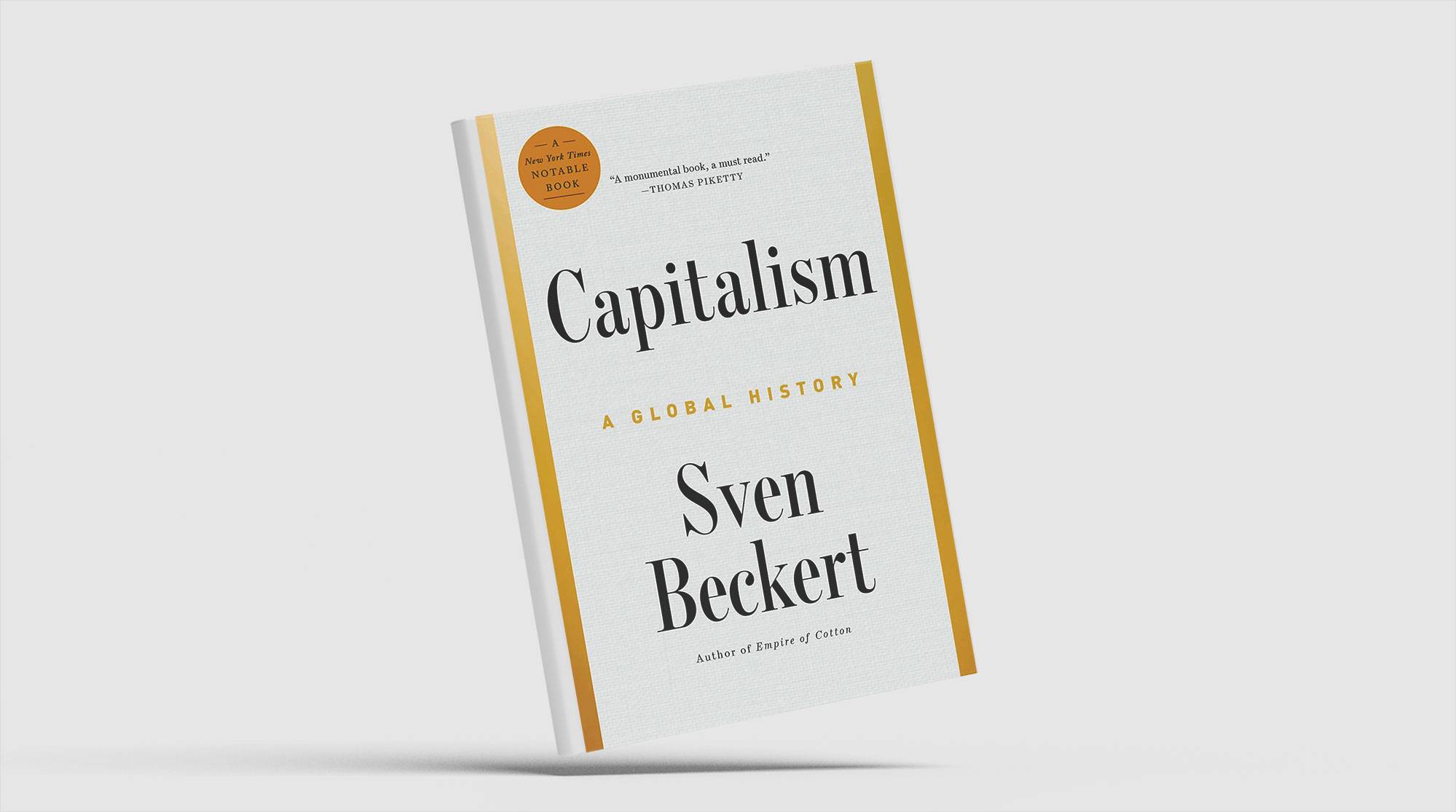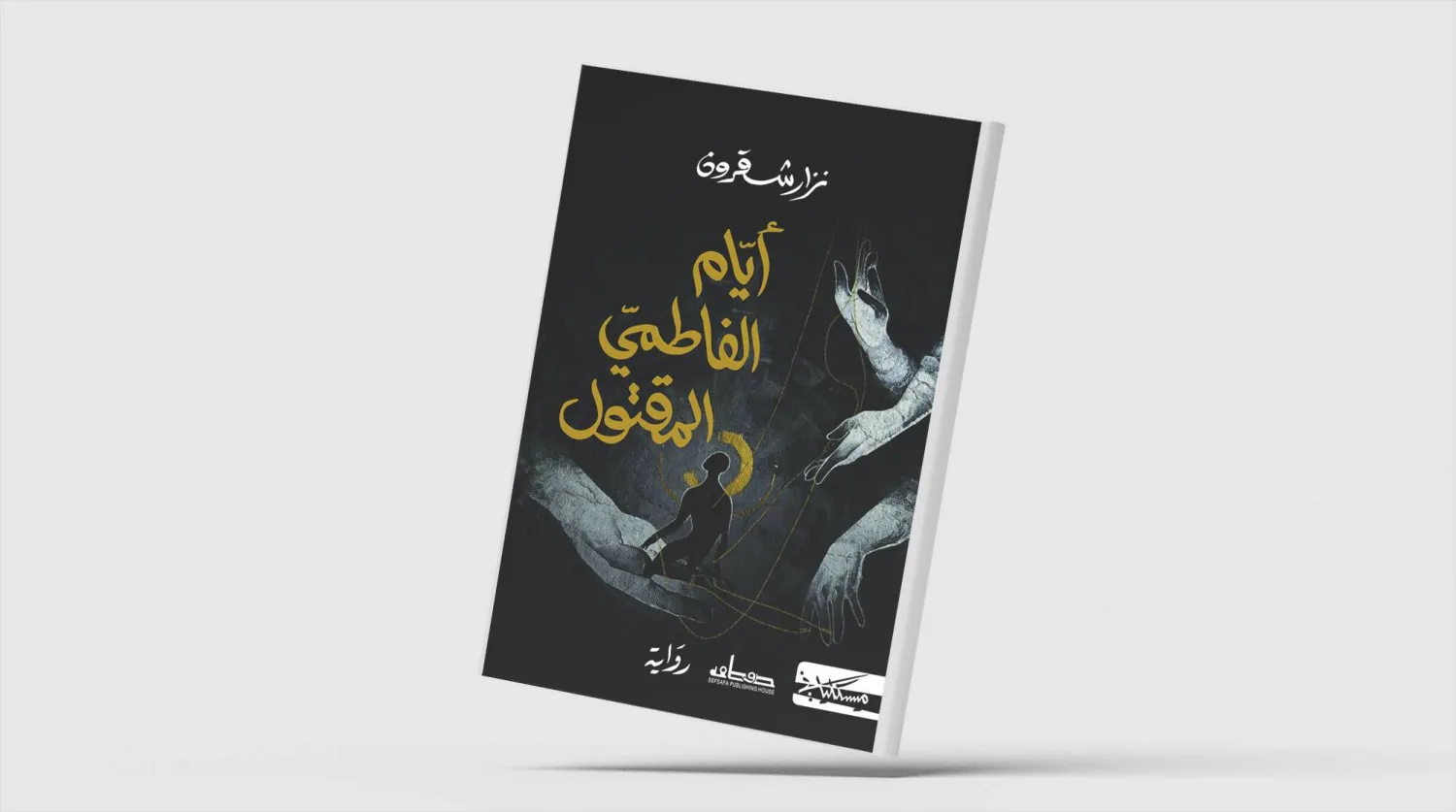تنهض الكتابة الإبداعية في القصة والرواية والشعر على جهد ذات مبدعة، تنفعل بما يدور في واقعها والعالم من قضايا وأفكار وصراعات، تعبّر عنها من منظور خاص وبرؤية فنية كاشفة تمتد لتشمل ما هو أعمق من حيث قوة الانفعال وكيفية اختيار الموضوع ونوعية الدلالات والرسائل التي تكمن خلف ظاهر النص؛ ما يجعل الإبداع في هذا المجال ظاهرة فردية بامتياز.
كل هذه المفاهيم التي تبدو بديهية ومسلّماً بها يتمرد عليها الكاتبان المصريان إدوار الخراط ومي التلمساني وينجزان معاً رواية مشتركة تحمل عنوان «صدى يوم أخير» صدرت مؤخراً عن دار «الشروق» بالقاهرة.
تتناول الرواية منحنيات المد والجذر والصعود والهبوط في علاقة غرام مجهضة بين «ليلى» الصحافية التي اندفعت بكل مشاعر لتقع في حب الفنان البوهيمي الوسيم، متعدد العلاقات، «إدريس». تجمع بينهما الموهبة الشديدة، هى في النقد والكتابة وهو في النحت البارع.
وكشفت مي التلمساني في مقدمة الرواية بعض كواليس تلك التجربة الأدبية النادرة، وأشارت إلى أن البداية كانت بين عامي 2002 - 2003 من خلال الكاتب إدوار الخراط الذي شرع في كتابة حلقات أدبية مسلسلة لمجلة «سيدتي» وهي إحدى المجلات العربية الشهيرة المهتمة بشؤون المرأة. وبعد أن انتهى من كتابة الفصل الأول، قام بترشيحها للكتابة معه رغم وجودها في كندا في ذلك الوقت. تفاجأت مي، لكنها رحبت بالطبع، لكن المشكلة أنه مع تنقلها للعيش في أكثر من بيت، ضاع منها المخطوط الأصلي، ولم تتذكره إلا عند وفاة إدوار الخراط، ثم وجدته بالصدفة أثناء بحثها على شهادة ميلاد نجلها زياد.
وتشير إلى أن إدوار الخراط كان شخصاً شغوفاً بالمغامرة والتجريب ورغم أنه ينتمي إلى جيل الستينات بينما هي تنتمي إلى جيل التسعينيات، فإنه لم يدخل التجربة بروح سلطوية ولكن بروح شخص يعرف بشكل مطلق الحقيقة الكاملة وسيدلي بدلوه في النص الأدبي، وكان هذا يعطيها مساحة من الحرية حول تجربة فكرة جديدة من خلال الرواية المشتركة.
وتطرقت مي التلمساني إلى ملابسات اختيار عنوان الرواية، موضحة أن الخراط وضع لها الكثير من العناوين، منها «النحات والصحافية» و«الفنان والصحافية» ثم «غرام وانتقام»، وتم نشره العمل بهذا العنوان في المجلة، لكنها استقرت على «أصداء يوم أخير» الذي استلهمته من فصل كتبه الخراط، حيث وجدت أنه أكثر تعبيراً عن روح العمل لا سيما «الألعاب المخفية في العلاقات الإنسانية».
وأضافت: لم نتحدث أنا وإدوارد مرة واحدة عن تلك التجربة في أثناء الكتابة، لم نتهاتف ولم نتكاتب، لم نطرح أسئلة أو نقترح خطة عمل أو نرسم مساراً محدداً للشخصيات. كنا نعمل في غيبة تامة كل منا عن الآخر معتمدين كل الاعتماد على وسائط قديمة أبرزها جهاز الفاكس.
وتوضح: اليوم أحب أن أطلق على هذه التجربة تعبيراً أستلهمه من المفكر المغربي عبدالسلام بنعبد العالي هو «الكتابة بيدين»، كنا إذن نسعى عن طريق «الكتابة بيدين» للانفلات من وطأة العمل وحدنا ولو إلى حين. نبحث عن خط انفلات من أنفسنا ونجده في نهاية المطاف في منطقة بين بين، أشبه بمنطقة الرسائل ولكن من دون النبرة الذاتية، منطقة تسمح باللعب ولا تصادر على النتائج أو هذا ما أتصور أننا سعينا له.
وتتسم تلك الرواية القصيرة أو «النوفيلا» بسرعة الإيقاع والتصاعد الدرامي اللاهث مع بساطة اللغة وجاذبية القصة من خلال علاقات الحب. ويبدو أن توجه النص في البداية إلى قارئ مجلة أسبوعية يبحث عن الترفيه هو ما أثر على بنية العمل وطبيعة اللغة.
عاش الخراط في الفترة من 1926 حتى 2008، وصدر له أكثر من 50 كتاباً بين القصة والرواية والشعر والنقد والترجمة. شكلت إبداعاته عند ظهورها نهاية الخمسينات منعطفاً في السرد العربي، حيث ابتعدت عن الواقعية التقليدية وركزت على وصف الأرواح المعرّضة للخيبة. وصك مصطلحات جديدة في النقد مثل «الحساسية الجديدة» و«الكتابة عبر النوعية» وعرف بانحيازه للتجريب وانفتاحه على تجارب الأجيال الجديدة. حصل على العديد من الجوائز منها جائزة الدولة التقديرية، وجائزة ملتقى القاهرة للرواية، ومن أبرز أعماله «رامة والتنين» و«ترابها زعفران».
وتقيم مي التلمساني في كندا منذ 1988 وهى روائية وناقدة من أبرز أعمالها «هليوبوليس» و«أكابيلا» و«الكل يقول أحبك». حازت في 2021 وسام الآداب والفنون برتبة فارس من الحكومة الفرنسية.
ومن أجواء الرواية نقرأ:
«كانت الحفلة قد شارفت ذروتها، تلك أكثر اللحظات إمتاعاً. اللحظة التي تأتي مباشرة قبيل الذروة، لعلها أمتع وأكثر إرواءً من لحظة الذروة نفسها. عندما دق جرس الباب بإصرار وإلحاح متصل جعلنا جميعاً نتوقف لبرهة خاطفة عما كنا بسبيله من أكل وحديث وغزل بريء وننظر إلى الباب بترقب.
دخل إدريس بقامته الشامخة ووجهه الصخري المنحوت وخطوته الوئيدة يحمل شيئاً ملفوفاً في ورق أصفر خشن ملفوف بدوبارة ويبدو وكأنه هدية يوم ميلاد. ولكن كما يُنتظر من إدريس، المظروف غير مغلف بالورق اللامع المنقوش بزخرفات زاهية.
لم يلق إدريس سلاماً ولا كلاماً، بل ذهب مباشرة إلى ليلى ومن غير كلمة مزق الورق الأصفر الكابي عن هديته وكشف عنها. كانت ليلى في اللوحة تنظر إلينا رائعة وفاتنة. قامت البنية المحروقة في نحولها الرشيق متكئة براحته تكشف لنا دون أدنى خجل وربما بشيء من الزهو المكتوم عن أنوثتها مرهفة الجوانب.
ليلى في اللوحة التي صورها إدريس بحب وبصيرة تبدو قادرة على تملك حريتها، على تملك قسماتها وتطلعها الحر الذي لا يدين بشيء ولا بأحد غير ذاته. قامتها في رقتها ونعومتها الخفية ليست ملكاً لأحد ولا حتى لصاحب اللوحة، ليست ملكاً إلا لذاتها ولكن من غير مباهاة ولا ادعاء، بل ببساطة متخلصة من كل زيف ومن كل التباس».