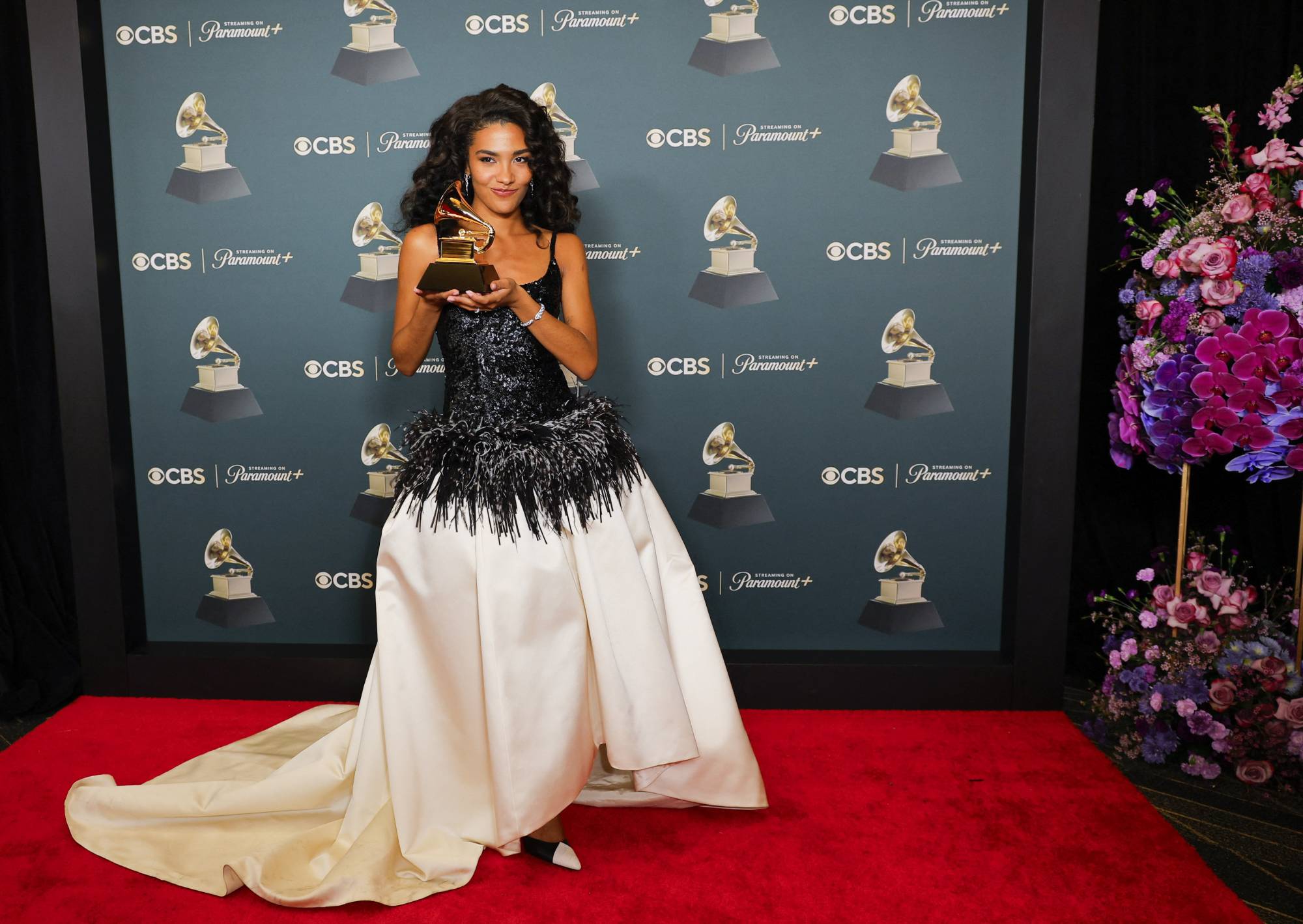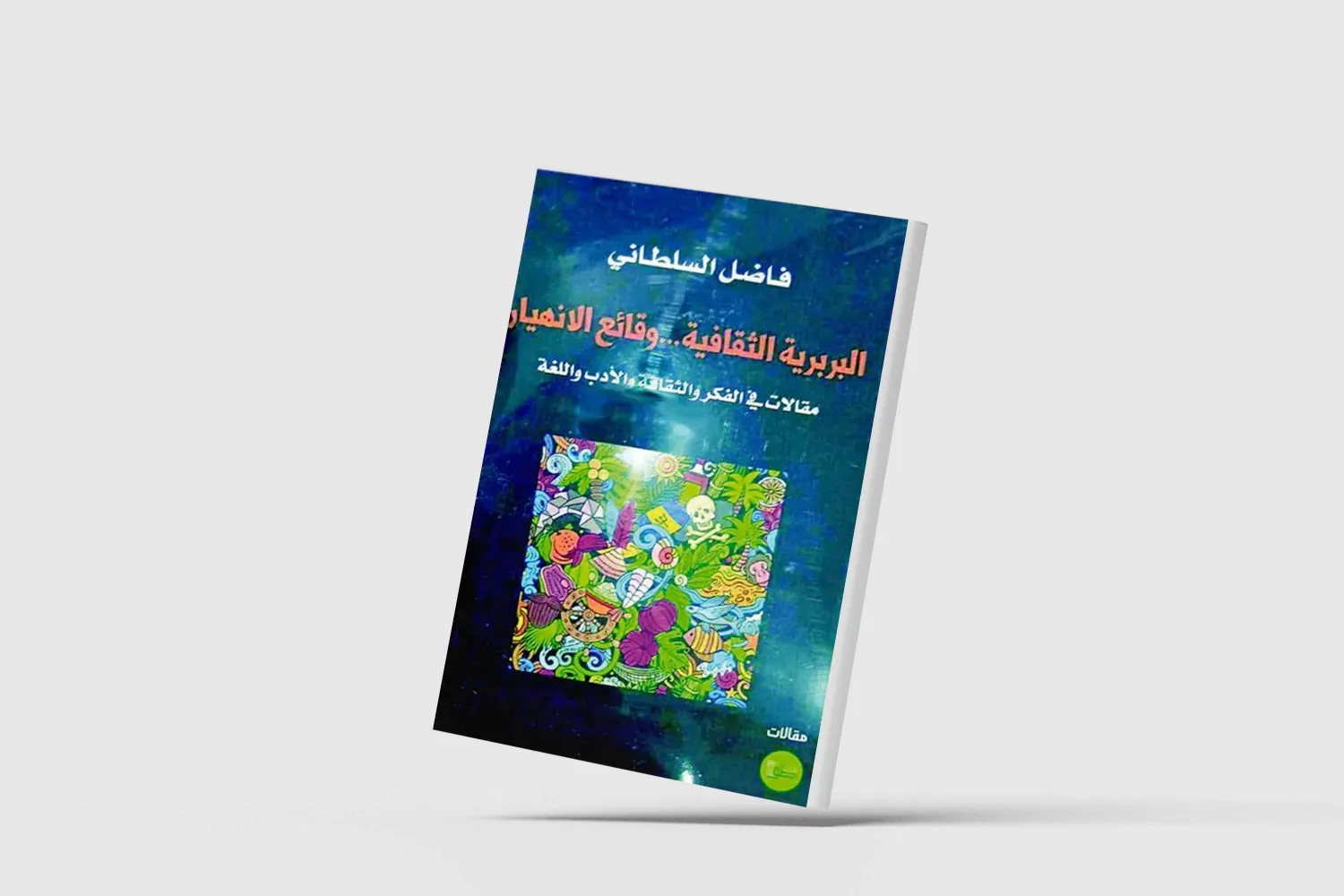يكتب الدكتور عبد الله بن إبراهيم العسكر في كتابه «البعد الثقافي في حياة الملك سلمان»، وهو في الأصل محاضرة ألقاها في نادي الأحساء الأدبي، أن «وجود الملك سلمان بن عبد العزيز على رأس هرم الدولة السعودية المعاصرة سيجعل الثقافة بكل تفرعاتها تنال القدح المعلى من اهتمام الملك»، مؤكدًا أنه لا يستبعد أن تشهد البلاد في عصره نهضة ثقافية، ملمحًا في هذا الصدد إلى ما قرأه مؤخرًا عن قيام وزارة الثقافة والإعلام بالعمل على إعداد مسودة لمشروع الملك سلمان بن عبد العزيز للنهوض بالثقافة.
ويشير المؤلف إلى أنه قرأ أن الملك سلمان لديه فكرة مكتملة عن الثقافة بوصفها مشروعا وطنيا متكاملا على غرار مشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء، وأزعم أن الثقافة كصناعة هي ما نحتاجه في بلدنا. وأضاف: «ولا يخالجني شك أن بلدنا ومجتمعنا في حاجة ماسة إلى مشروع ثقافي واسع. ولا يمكن تحقيقه في بلدنا إلا بإرادة سامية ورعاية ملكية».
وقال المؤلف إنه «متيقن أن الملك سلمان هو الشخص الوحيد القادر على إطلاق مثل هذا المشروع الخيري، ذلك لأنه ملك مثقف، وهو فوق هذا يملك الطموح المعرفي والثقافة الواسعة للتناهي مع مثل هذا المشروع على النطاقين النظري والتطبيقي».
ورأى العسكر أنه في حالة تحقق ما قرأ عنه فستكون السعودية على موعد لنقلة ثقافية شاملة. ويضيف: «أنا هنا أتحدث عن الثقافة ليس بمفهومها المعجمي الكلاسيكي، بل بمفهومها الابستمولوجي الواسع، ذلك أن الثقافة تدخل في مفاصل الإدارة المجتمعية بشكل ممتد».
وذكر العسكر أن للملك سلمان مع الثقافة، في أوسع تعريفها، حكاية ذات جانبين: الأول جانب تاريخي. والآخر جانب معرفي متشعب. ومفهوم الثقافة عند الملك سلمان لا يختلف عن التعريف المعجمي العربي، والتناول الثقافي الكلاسيكي، وهو الأخذ من كل بحر قطرة، لكنه تعدى هذا التعريف بأن انتخب ما يميز شخصيته ويتلاءم وينسجم مع تكوينه الذهني، وثقافة المحيط الذي عاش فيه سني حياته الأولى.
وأشار الباحث إلى أنه من هذا المنطلق يمكن القول إن «المعارف العامة هي أساس التكوين الثقافي عند الملك، لكنه مع هذا نراه يهتم بجوانب ثقافية يخصها دون غيرها مثل: التاريخ العام والتاريخ السعودي بمراحله الثلاث، وعلم الأنساب العربية، ويخص أنساب القبائل العربية في جزيرة العرب، وكذلك كل ما يتعلق بالبلدانيات في بلاده»، لافتًا إلى «إننا لا نستثني البدايات الأولى التي طبعت شخصيته المتميزة.. ومما عرفت عن قرب أنه في مقتبل سن الشباب وما بعده كان على اطلاع واسع على المجالات الثقافية التي كانت تصدر في لبنان ومصر وعلى رأسها مجلة الهلال الرصينة»، موردًا حديثًا للأمير عبد العزيز بن سلمان أشار فيه إلى أن «إصدارات الهلال ودار أخبار اليوم من مجلات وكتب كانت تصلنا في البيت باستمرار، وكان والده يأتي بها في وقت يسير». أما شغفه بالكتب فحدث ولا حرج، حتى تكونت لديه مكتبة تعد من أكبر المكتبات الخاصة في السعودية، ومن أكثرها غنى بكل ما هو نادر ومفيد في مختلف المعارف الإنسانية.
وأكد الدكتور العسكر على أن هذا الاكتناز المعرفي، وحب القراءة والاطلاع، واقتناء الكتب الذي لازمه حتى اليوم على الرغم من شواغله، كل ذلك جعل الملك سلمان واحدًا من أكثر الملوك في العالم المعاصر حبًا للثقافة، والتصاقًا بالمثقفين من سعوديين وغير سعوديين، فكان يدعوهم ويحتفي بهم، ويمازحهم ويحاورهم فيما يطرحون، ويناقشهم فيما يكتبون، وكانوا كثيرًا ما يستفيدون من أفكاره النيرة، وآرائه الصائبة، وهو وراء كثير من الفعاليات والمنجزات الثقافية.
وذكر الباحث أنه، وبسبب اهتمام الملك سلمان الزائد بالثقافة والفكر، فإنه يقتطع من وقته مساحة للقراءة والاطلاع. وهو كما يصفه أناس كثر قارئ نهم، ولديه مكتبة ضخمة تستقبل الجديد من الإصدارات التي تتعلق بفروع الثقافة ومناحيها، وما يخص تراث السعودية من كل أرجاء العالم، فضلاً عن مكتبة تلفزيونية تلاحق ما يبث في هذا الفضاء عن بلاده وشؤونها. ولعل مكتبته المنزلية خير شاهد على مستوى اهتمامه بالجانب الثقافي، إذ تحتوي رفوفها على ما يزيد على 60 ألف مجلد تغطي 18 ألف عنوان، بتنوع يشمل مختلف حقول المعرفة وميادين الثقافة. وبهذا القدر قد تكون مكتبة الملك سلمان أكبر مكتبة خاصة يملكها ملك في العصر الحديث. لكن شغفه بفرع من فروع الثقافة، وهو التاريخ، يفوق سائر الفروع.
ولفت الدكتور العسكر إلى أن الكُتّاب في السعودية وخارجها اهتموا بسيرة الملك سلمان بن عبد العزيز، وكتبوا عنه مقالات مطولة وقصيرة، وحاولوا أن يغوصوا في شخصيته، مبرزين أهم صفاته العلمية والثقافية ورؤاه السياسية والفكرية، موردًا رصدًا ببليوغرافيا عما كُتب عن الملك سلمان أصدرته مكتبة الملك فهد الوطنية والتي بلغت نحو 1148 مادة علمية وثقافية تُغطي حقبة زمنية، وتوقفت عند عام 2011 أي قبل أن يصبح ملكًا لبلاده.
وتناول الباحث المحتوى الفكري للثقافة عند الملك سلمان الذي لقب بالملك المؤرخ بلا منازع، والذي جاء بسبب جهوده الدؤوبة وحرصه المتميز على حفظ تراث بلاده والجزيرة العربية، واعتنائه بالتاريخ عناية تتعدى اهتمام أمير وملك إلى عناية مؤرخ متمكن صرف وقته في درس التاريخ والعناية به. وقد أكسبته قراءته التاريخية وعيًا مختلفًا عن غيره من ملوك وزعماء العالم.
وقد أجمع كل المتخصصين على أن الملك سلمان واسع الثقافة ممتد المعرفة عميق الحكمة قارئ من الطراز الأول، كما عرفه المتخصصون في علوم التاريخ والأنساب وما يؤثر في بناء المجتمعات وتأسيس الحضارات محاضرًا وكاتبًا ومحققًا في هذا الشأن بل رائدًا في رعاية هذه العلوم، ومصداق ذلك أنه خلال عام واحد، وبالتحديد في يناير (كانون الثاني) 2008 – أغسطس (آب) 2009، كتب ونشر الملك سلمان 19 مقالاً تاريخيًا وثقافيًا، بل إن ما نشرته دارة الملك عبد العزيز التي يرأس مجلس إدارتها من بحوث فكرية أو تاريخية، كانت تمر على الملك سلمان بن عبد العزيز ليعطي رأيه فيها قبل أن تنشر على الملأ.
7:28 دقيقه
الملك سلمان.. ثقافة الوطن ووطن الثقافة
https://aawsat.com/home/article/473571/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%88%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9



الملك سلمان.. ثقافة الوطن ووطن الثقافة
تعد مكتبته من أكبر المكتبات الخاصة في السعودية وتضم 60 ألف مجلد تغطي 18 ألف عنوان

غلاف الكتاب
- الرياض: بدر الخريف
- الرياض: بدر الخريف

الملك سلمان.. ثقافة الوطن ووطن الثقافة

غلاف الكتاب
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة