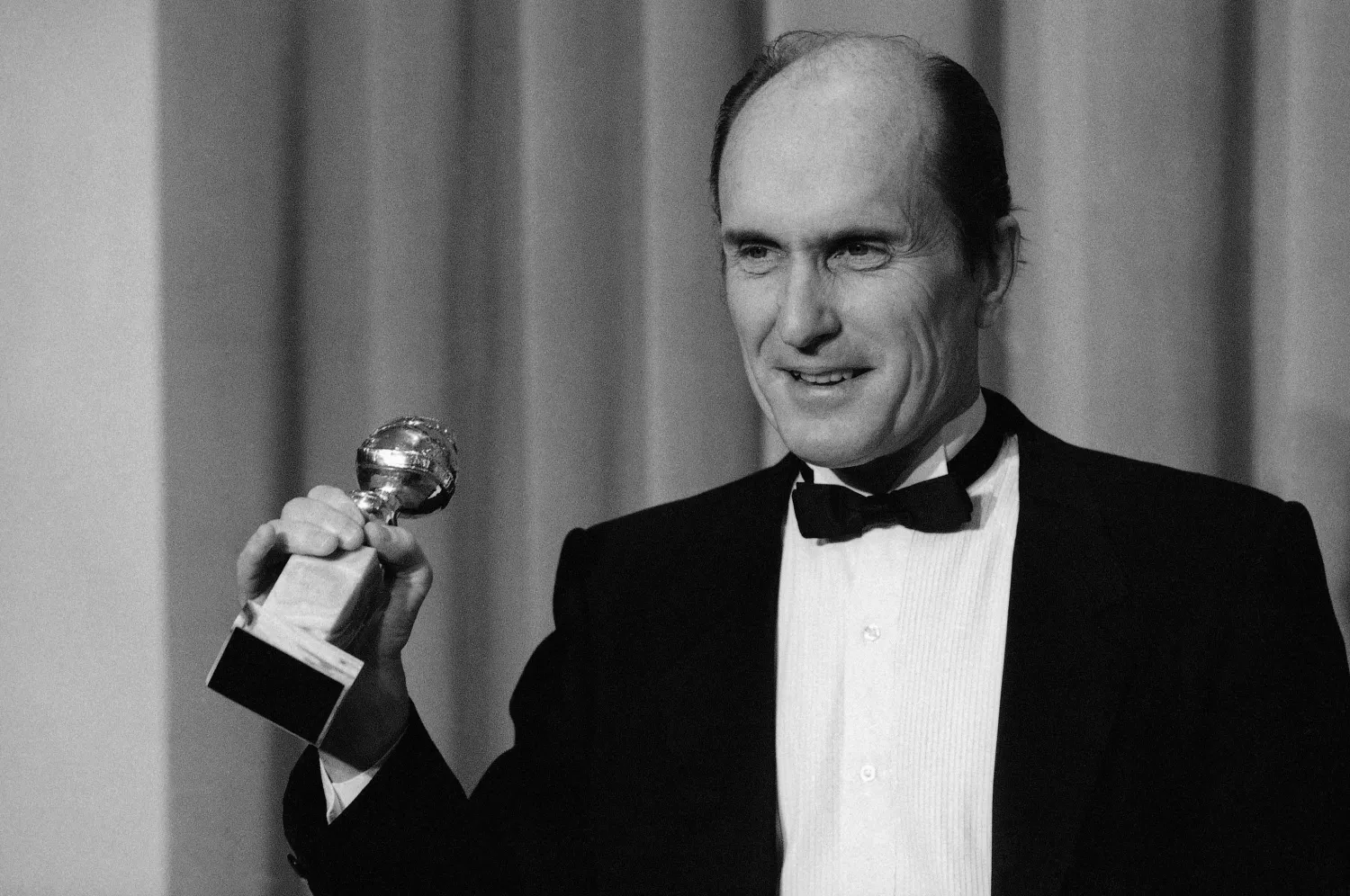في الخامس من شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2004، جرى تقديم الحفلة الأولى من مسرحية غنائية باسم «جيرزي بويز» («فتيان جيرزي»). كان التحضير لها بدأ عامين ونصف العام كفكرة نمت سريعا وبحماس. فالعنوان هو تغليف لقصـة حياة فرقة غنائية ترعرعت في الخمسينات ووصلت إلى ذروات نجاحها في الستينات باسم «الفصول الأربعة» أو «ذا فور سيزنز». من ذلك الوقت والمسرحية الموسيقية مستمرة (أكثر من 3480 عرضا حتى الآن) وبنجاح لم يتوقـعه أحد من أعضاء الفرقة ولا ممن ساهموا في تحقيق الفكرة من كتـاب ومسرحيين.
في عام 2010، تقدم الفريق، الذي توقـف عن الغناء المسجـل منذ عقود، بمعالجة سينمائية إلى بضع شركات هوليوودية. ثم عاد وأرسل معالجة أخرى في العام التالي. وفي عام 2012، أرسل سيناريو كاملا. كان ذلك في يونيو (حزيران) من تلك السنة. حتى نهايتها، كان المشروع ينتقل من مكتب إلى آخر من دون أن يجد من يوقع على شرائه وإنتاجه. في النهاية، ومع مطلع عام 2013 وافقت شركة وورنر على تمويله ووضع على «الطريق السريع»، إذ ما إن حل ربيع ذلك العام حتى بدأ العد التنازلي للتصوير الذي جرى بدءا من الصيف وحتى منتصف الخريف. في مثل هذه الأيام قبل عام واحد، دخل المشروع مرحلة ما بعد التصوير. وفي الخامس من يونيو من هذا العام، عرض على الشاشات الأميركية والعالمية: 134 دقيقة من فن البيوغرافي والغناء تكلـفت 40 مليون دولار. الفيلم دام أقل من 5 أسابيع من العروض السينمائية، بعده سُـحب من العرض مكتفيا بـ60 مليون دولار من الإيرادات. تبعا للحصص وتكاليف التوزيع، كان بحاجة إلى 90 مليون دولار لكي ينجز أرباحا.
الحق ليس على المخرج كلينت إيستوود. خامته كمخرج لا تتغيـر من فيلم لآخر. استعرض الفيلم حياة الفريق على نحو يقف عند كل المحطـات المهمـة: الخلفيات الشخصية، المحطـات الأولى، النجاحات، الصراعات، الإخفاقات. وفي كل ذلك، حافظ على إيقاع جيـد. إيستوود مخرج كلاسيكي من دون أن يكون عتيقا. ملتزم بمنحاه من العمل من دون أن يكون معاديا للجديد. لكن شيئا ما حال دون نجاح الفيلم على النحو ذاته الذي حققته المسرحية، أو حتى قريبا من ذلك النحو.
اقترح البعض التالي: كلينت إيستوود لا يستهوي الجمهور الشاب، حتى ولو كان الفيلم يدور حول فريق شاب يمثله على الشاشة ممثلون دون الثلاثين؛ منهم فنسنت بياتزا وستيف شيريبا وجون لويد يونغ وجوني كانيزارو، لذلك أخفق الفيلم. لكن هذا ليس صحيحا. لا يكترث الجمهور السائد لمن يقف وراء الكاميرا، بل لمعيار آخر مختلف من العمل، هو مدى اقتناعه بأن الفيلم المعيـن سيحمل إليه الترفيه المطلوب. «جيرزي بويز» كان موجـها إلى المشاهدين الذين عاصروا أغاني «ذا فور سيزنز» وهؤلاء هم الذين غابوا.
* براعات متفاوتة
* ما يثير الدهشة هو أن حال فيلم «البؤساء» الذي جرى تقديمه قبل عامين اقتباسا عن مسرحية موسيقية أخرى عرضت طويلا على خشبات برودواي وحول العالم. هذا الفيلم تكلـف 61 مليون دولار وحقق 433 مليون دولار، من بينها 149 مليون دولار من الولايات المتحدة ذاتها. أخرجه توم هوبر الذي لم يسمع به أحد من الجمهور السائد من قبل، وقام ببطولته ممثلون فوق الثلاثين عموما، بينهم هيو جاكمان وراسل كراو وآن هاذاواي وهيلينا بونام كارتر. كيف إذن حقق هذا الفيلم كل هذا النجاح بينما سجل «جيرزي بويز» من الإيرادات ما يعكس قلـة الاهتمام به؟
«البؤساء» نال 3 أوسكارات، لكن ليس من بينها ما مُـنح له تحديدا. آنا هاذاواي نالت أوسكار أفضل ممثلة مساندة، وليزا وستكوت وجولي دارتنل نالتا أوسكار المكياج وتصفيف الشعر، و3 تقنيين نالوا أوسكار «مزج الصوت»، علما بأن الفيلم دخل المنافسة في 5 مجالات أخرى، من بينها: أفضل فيلم، وأفضل أداء رجالي رئيس، وأفضل تصميم فني.
وتاريخ الأوسكار مع الأفلام الموسيقية مثير بدوره:
ما بين مطلع الستينات ونهايتها حفلت الأفلام بجوائز الأوسكار: «أوليفر» و«رجل لكل الفصول»، ولا تنسى «سيدتي الجميلة» و«صوت الموسيقى». لكن 3 أفلام فقط هي التي حظيت بالأوسكار في السنوات الأربعين الأخيرة أو نحوها؛ وهي: «أماديوس» لميلوش فورمان (1984)، و«قيادة الآنسة دايزي» لبروس بيرسفورد (1989)، ثم «شيكاغو» لروب مارشال (2002). وكلـها كانت مسرحيات نقلت، ببراعات متفاوتة، إلى الشاشة الكبيرة.
«جيرزي بويز» ليس منفردا في إخفاقه: «آني» لروبرت ألتمن (1975)، و«شبح الأوبرا» لجويل شوماكر (نسخة 2004)، و«هيرسبراي» لأدام شانكمان (2007)، و«تسعة» لروب مارشال الذي أريد له أن يلي «شيكاغو» نجاحا (2009)، كلها اقتباسات من «مسرحيات موسيقية»، كان من المفترض، نظريا وعلى الورق، أن تجسـد بعض ذلك النجاح المسرحي السابق، لكن الصوت الوحيد الذي سُـمع منها هو صوت ارتطامها بالأرض حين سقطت.
بعض هذه الأفلام، ومنها «شبح الأوبرا»، حقق نجاحا لا بأس به في الأسواق الدولية، كذلك فعل «سويني تود» الذي أنجزه تيم بيرتون عام 2007. إيراداته الكلية لم تكن كبيرة: 146 مليون دولار، وفي أميركا اكتفى بـ53 مليون دولار، مما يجعل إيراده العالمي لا يزيد على 93 مليون دولار. الفيلم تكلـف 50 مليون دولار وكان بحاجة إلى 125 مليون قبل أن يعد نفسه رابحا. الإيراد الكلي المسجل بالكاد أعاد إلى الجيوب بعض تكلفته.
* غائبون
* هناك ملاحظة واحدة تتراكم، إلى حد، في هذا الموضوع وقد تفسـر سبب نجاح «البؤساء» وإخفاق «جيرزي بويز» أو ما سواه، وهي أن عنصر الاهتمام هو الذي سيطر، بما فيه الكفاية، على المشاهدين: أولا: هي فرصة لمشاهدة قدرات هيو جاكمان وراسل كراو الصوتية (إذ قاما بالغناء فعلا)، وهو أمر لم يتح لفيلم إيستوود (رغم قيام أبطال الفيلم بالغناء). وثانيا: هناك حكاية خيالية، وليس سيرة ذاتية، تتولـى توريد الحكاية. من ثم، نستطيع القول إن المؤلـف فيكتور هوغو، الذي وُلد ورحل قبل ولادة الفيلم الأول (1802 - 1885)، هو الذي باع التذاكر أكثر ممن سواه.
لكن هذا ليس ضمانة. في هذه الأيام ،لا نرى أعمالا سينمائية لتنيسي ويليامز أو نيل سايمون أو جيمس ثوربر أو غور فيدال أو بول أسبورن أو نورتون فوت، أو هارولد بينتر؛ لا منفـذة عن أعمال جلاى إنتاجها للمسرح ولا باقتباس مباشر من المصدر. وذلك مرجعه هو أنها تتطلب عناصر معيـنة، من بينها أسماء معروف عنها صلابة وضعها في مثل هذه الأفلام. أسماء مثل أودري هيبورن أو كاثي بايتس أو ميريل ستريب أو ليزا مانيللي أو بابرا سترايسند. بعض هؤلاء رحل وبعضهم ما زال حيـا، لكن حتى مع الاستعانة بممثل يركن الجمهور إلى خبرته الغنائية، فإن فرص النجاح تبقى محدودة وأقل مستوى من الميزانية التي سيجري عبرها إنتاج الفيلم.
الأمر أصعب بالنسبة إلى الأعمال الموسيقية بالطبع. ليس فقط أنها عرضة لكي تكلـف أكثر، بل هي عرضة لأن تفشل أكثر كذلك، خصوصا في هذه الأيام إلا إذا ما سادتها تلك العوامل الخصوصية فعلا، كما حدث مع الفيلم المقتبس عن تراجيدية فيكتور هوغو.
* المسرحي الأكثر نجاحا
* عاش ويليام شكسبير حياة رغيدة لا بأس بمستواها المادي، لكنه لو كان حيـا اليوم لكان مليارديرا. أو لو أن قانون الحقوق ما زال يشمله لكان وارثوه يحلـقون في نعيم النجاح الاقتصادي: 1028 فيلما سينمائيا جرى تحقيقهم مباشرة عن أعماله («ماكبث»: «هاملت»: «روميو وجولييت» إلخ…) من عام 1878 وإلى اليوم، وهناك 20 جديدة في مراحل إنتاج مختلفة.