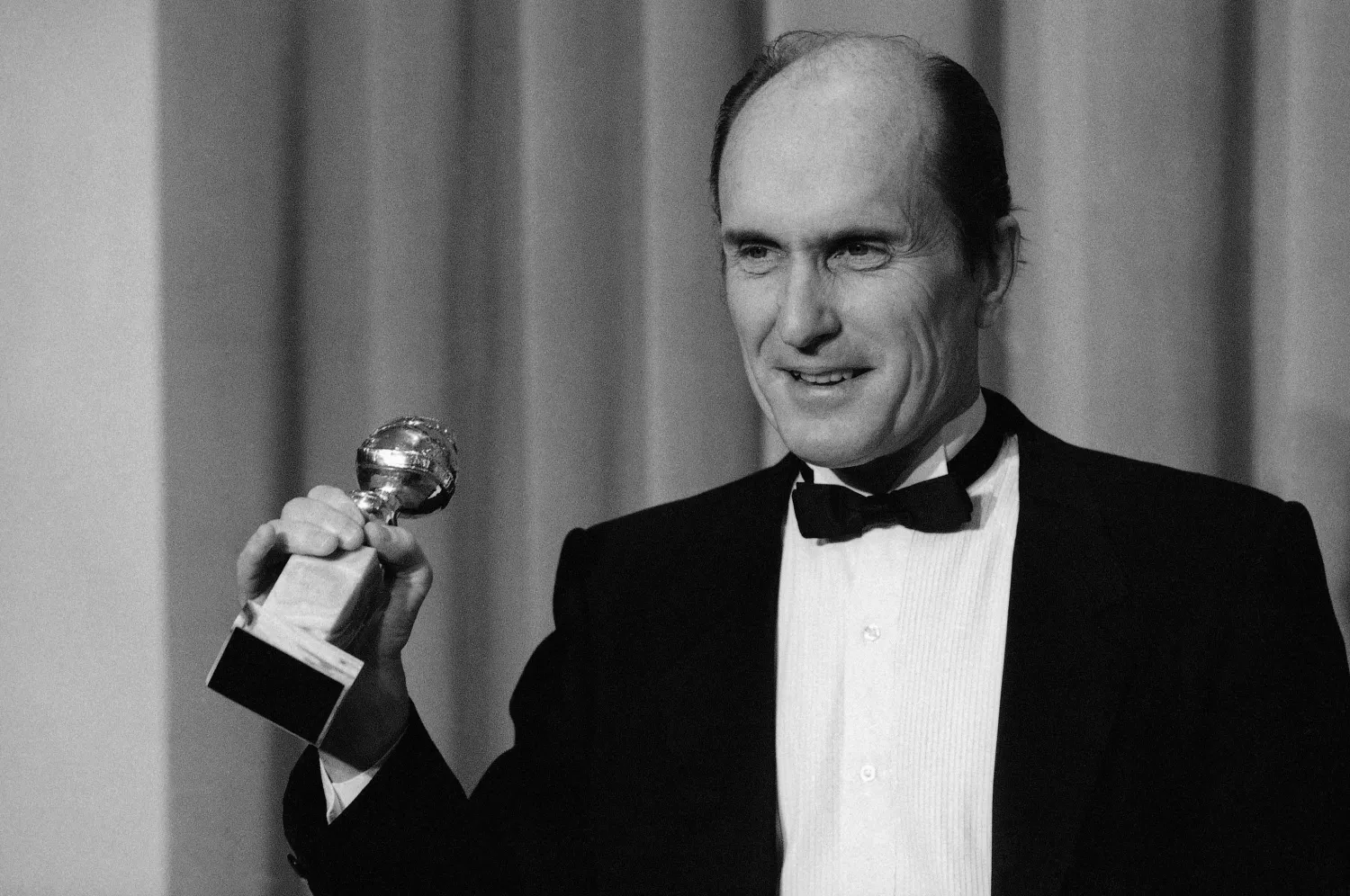La Grande Guerra - (1959)
كوميديا عن تلك الحرب العظمى
يكشف فيلم «الحرب الكبرى» (الذي نال ذهبية مهرجان فينيسيا لكنه أخفق في الفوز بأوسكار أفضل فيلم أجنبي) عن سعي مخرجه ماريو مونيشللي لاستلهام فن تصوير وتوليف مشاهد القتال والمعارك من أفلام السينما الصامتة. في تلك المشاهد دون سواها نجد اللحظات التي يمضيها المخرج مع الصورة أكثر من تلك التي يمضيها مع الكلمة. تسبح خلالها الكاميرا فوق مواقع القتال وتلتقط ناجين وضحايا وشظايا. في ذلك استخدم المخرج، أربعة مصوّرين لإنجاز التأثير والوقع المطلوبين لتلك المشاهد.
ترك مونيشللي القصّة بسيطة من حيث الجوهر: جنديّان إيطاليان (الراحلان ألبرتو سوردي وفيتوريو غاسمان) ينخرطان في الجيش الإيطالي في الحرب العالمية الأولى ويتعاملان مع قيادة ستسيطر بقراراتها على حياتيهما وحياة الفيلق بأسره، وسترسلهما للاشتراك فيما عُرف بمعركة «نهر بيافي» التي وقعت سنة 1918 وهي معركة خاضتها إيطاليا لجانب قوّات محدودة فرنسية وبريطانية ضد الجيشين النمساوي والمجري وكانت الانتصار الكبير الأول للإيطاليين بعد هزيمتين متواليتين في العام نفسه، مما يجعل من الصعب قبول الفيلم كنموذج معاد للحرب.
على ذلك، فإن الكثير من النقاد الأوروبيين اعتبروا فيلم مونيشيللي تحفة سينمائية جديرة موازية لفيلم ستانلي كوبريك «ممرات المجد» (1957)، وهو بالفعل عمل يجمع عناصر تنفيذ جيّدة لكنه لا يحقق المستوى الموازي لأفلام أخرى في الإطار ذاته مثل فيلم كوبريك أو مثل «كل شيء هادئ على الجبهة الغربية» للويس مايلستون (1930). ليس فيلماً مبتهجاً، ولو أن معالجته كوميدية في المشاهد البعيدة عن خطوط القتال، لكن الرسالة لا تبلغ شأنها إلا مروراً بفصول كثيرة من المشاهد ذات الحوار المكثّف.
يبدأ المخرج فيلمه بتصميم مشهدي جيّد: لقطة طويلة واحدة لصف طويل واحد من الإيطاليين المصطفّين تمهيداً لضمّهم إلى الجندية. صداقة تنشأ بين رجلين تستمر وصولاً إلى جبهة القتال. هناك خمسون دقيقة من الفيلم مصروفة على هذه المعايشة في الجبهة الداخلية وتقديم الشخصيات المحيطة وعلاقة القيادة بالجنود وموقف مونيشيللي المنتقد للأولى. بعد ذلك نحو سبعين دقيقة من الحياة في الجبهة الأمامية حيث تلك التصاميم المثيرة للإعجاب التي يبرز فيها شغل كاميرا مستوحى من أفلام حربية صامتة وسابقة من بينها «الاستعراض الكبير» (كينغ فيدور - 1925) و«ما ثمن المجد» (راوول وولش - 1926). فيلم مونيشللي، على ذلك، يعمل على خط وسط بين الدراما والكوميديا. موضوع جاد بتعابير هزلية ومواقف تخدم الممثلين الرئيسيين من حيث دوران الفيلم حولهما أكثر من إتاحة الفرصة لنظرة بانورامية تشمل شخصيات أخرى إلا بقدر ما هو ضروري.
على هذا الصعيد، فإن المخرج المعروف كصانع أفلام كوميدية عموماً، يطلق الكثير من المفارقات المناسبة لبطليه. ينشغل بهما، مما يجعل الشخصيات الأخرى في الفيلم منزوية بمن فيها الشخصية الأنثوية التي تؤديها سيلفانا مانجانو.
مونيشيللي من مواليد مقاطعة توسكاني سنة 1915 (توفي سنة 2010) دخل العمل السينمائي سنة 1936 بأفلام قصيرة ثم شارك المخرج ستينو (كان مشهوراً آنذاك) سلسلة من الأفلام الكوميدية الخفيفة حتى قام مونيشيللي بتحقيق أول فيلم من إخراجه وحده وهو «ممنوع». «الحرب الكبرى» اعتبر أفضل فيلم حققه في حياته.