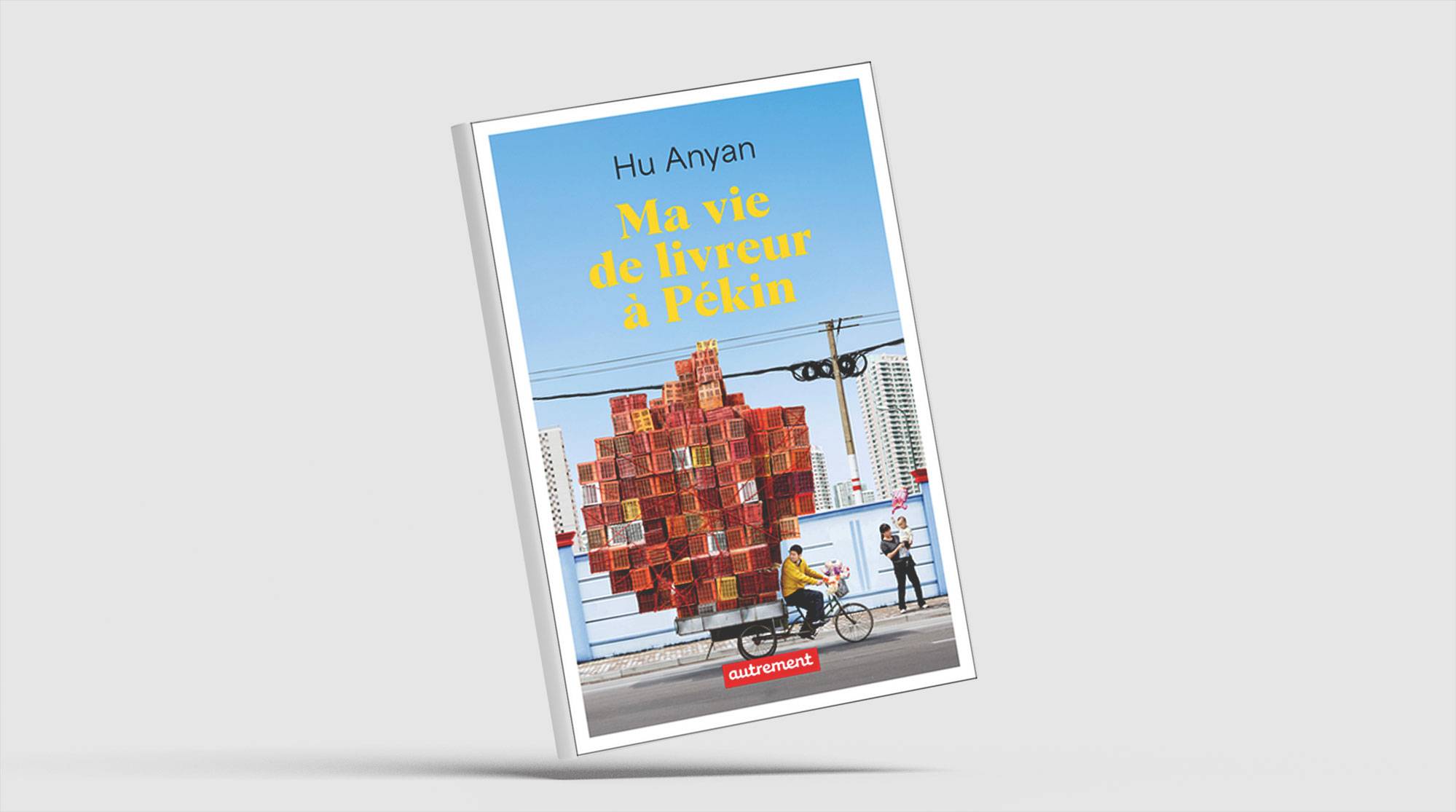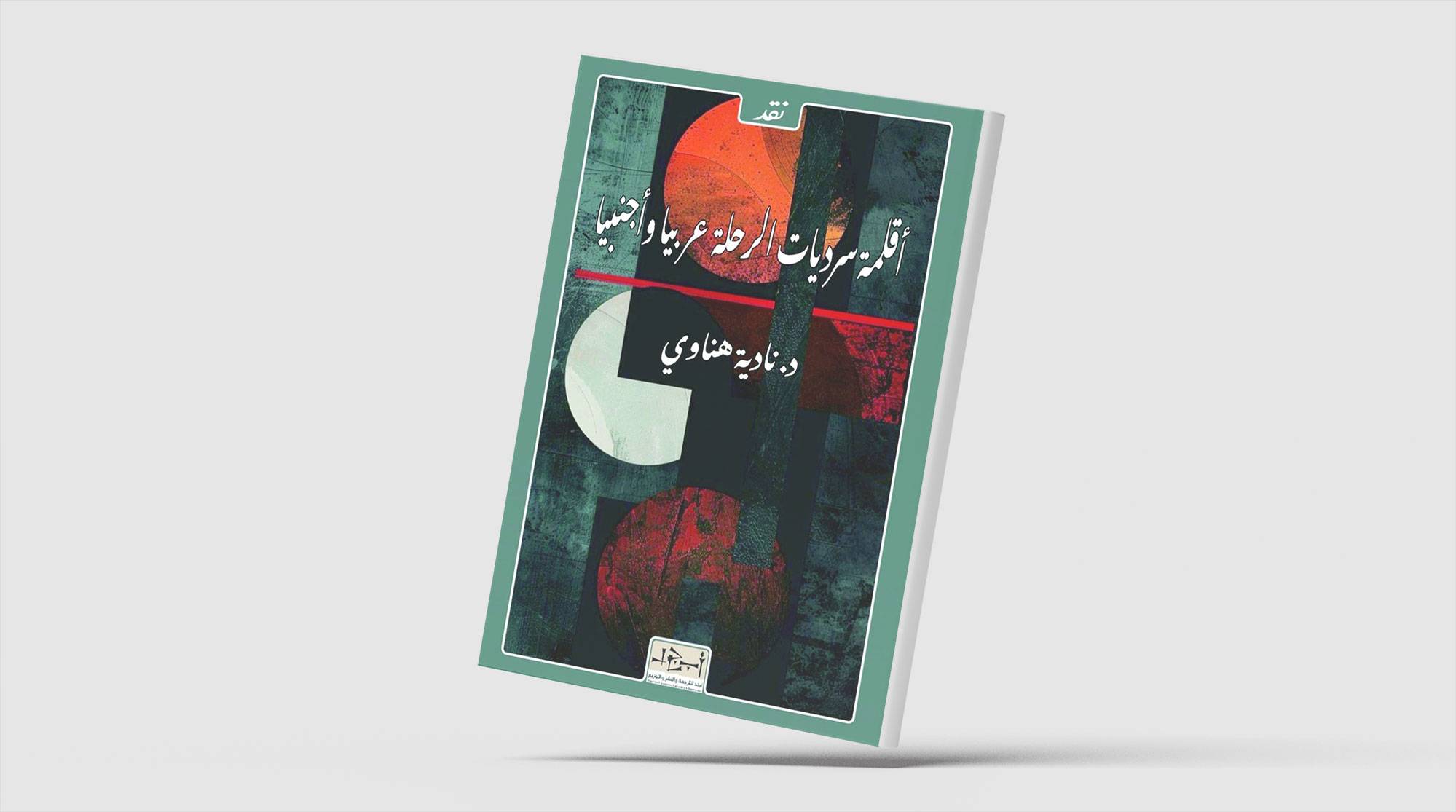يسعى كتاب «الإسلام في أوروبا: إشكاليات الاندماج وتحديات الإرهاب»، والصادر عن مركز المسبار للبحوث والدراسات، ضمن إصدارات الكتاب الشهري، إلى البحث عن إشكاليات الهوية والاندماج وتحديات الإرهاب لواقع المسلمين في أوروبا.
شارك في تأليف هذا الكتاب عدد من الباحثين الذين درسوا الحالة الإسلامية في أوروبا؛ حيث يسعى الباحث الجزائري محمد زناز، في بحثه الذي يتضمنه هذا الكتاب إلى الإجابة عن أسئلة من قبيل: إلى أي مدى تجذَّر الدين الإسلامي في أوروبا؟ وإلى أي مدى أصبح جزءًا من الثقافة الأوروبية؟ وهل تصالح المسلمون مع قيم الحضارة الأوروبية، وهل اندمجوا في المجتمعات الأوروبية وكيَّفوا معتقداتهم مع قيم الغرب الأوروبي؟
ويركز الباحث على الحالة الفرنسية لاعتبارات كثيرة أهمها: كون فرنسا الدولة العلمانية الوحيدة في أوروبا، علاوة على أنها أهم بلد يتمركز فيه المسلمون؛ إذ يشكلون نحو (10 في المائة) من مجموع السكان، معتبرا أنه من خصوصيات الحداثة الأوروبية أنها وضعت الفرد في المركز، وبما أنه كذلك، فالفرد ليس شيئا، وإنما هو شخص قادر على المعرفة، على امتلاك نفسه ووهب ذاته بكل حرية، والدخول في علاقات مع أشخاص آخرين. وهو ما أصبح يعرف باستقلالية الفرد (ذكرا أو أنثى) مع الحداثة الأوروبية؛ إذ بات يتمتع بحقوق سياسية وقانونية يصعب إيجاد نظير لها في الثقافات الأخرى، إن لم تكن تتناقض معها تماما، كما هو حاصل في الثقافة الإسلامية. فإلى اليوم لا يمكن الحديث عن فرد ولا مواطن بالمعنى الحقيقي العصري في كل البلدان العربية والإسلامية؛ إذ لا تزال «الأنا» غارقة في «النحن».
وبعد أن ترصد دراسة زنار كيفية تعامل الإسلام في أوروبا مع المواثيق وحقوق الإنسان الكونية، يتطرق الباحث إلى آلية تعاطي المسلمين مع مفاهيم المساواة بين الجنسين. ويقول: «تستورد الجاليات الإسلامية إلى قلب أوروبا بعض السلوكيات والتقاليد التي لا تتلاءم مع ثقافة المجتمع الغربي المضيف؛ وأهم مثال على ذلك تزويج القاصرات رغم أنوفهن في فرنسا وألمانيا وغيرهما».
من جهتها ترى الباحثة التونسية روضة القدري، أن صعود «الإسلاموفوبيا» في فرنسا تفاقم في العقود الأخيرة، وهذه الظاهرة تفسر بعوامل عدة - عززت أشكالا أخرى من كراهية الأجانب في أنحاء العالم - من بينها: الأزمة المالية والاقتصادية المستمرة منذ بداية السبعينات، مع ما تحمل من معدل بطالة، وإقصاء، وتدني شروط الحياة عند شرائح واسعة من المجتمع، وحرمان وفقد أمل، ومخاوف وغيظ في صفوف ضحايا هذه الأزمة.
ومن خلال البحث تناولت القدري تاريخ العلاقة بين الفرنسيين والإسلام في فرنسا على مراحل ثلاث: بين أواسط السبعينات ونهاية الثمانينات، ثم المرحلة الثانية التي تمتد من الثمانينات إلى 2001، تليها المرحلة الثالثة التي تبدأ بعد الاعتداءات التي أعلنت عنها القاعدة في الولايات المتحدة، التي تتابعت بعد ذلك جراء التدخل الثاني في العراق؛ حيث شهدت فرنسا نموا كثيرا من أشكال الصراع ضد الإسلاموفوبيا، وقد تولى ذلك جمعيات الشباب المسلمين (والمسلمات)، مثل: اتحاد الشباب المسلم، التجمع ضد العنصرية والإسلاموفوبيا، السكان الأصليين للجمهورية، والمثقفين والمثقفات بالثقافة الإسلامية. هذا إلى جانب التنظيمات التي تتحرك ضد كل أشكال كراهية الأجانب باسم الأفكار الإنسانية والكونية وحقوق الإنسان.
وتختم الباحثة باستنتاج أن «الأصولية التجارية أو الاقتصادية» وهي أصل هذا التطور أدت إلى نتيجة، أو إلى مكمل لها وهو «الأصولية الدينية». وترابُط هذين النمطين من الأصولية قد شجع على الانطواءات على الهوية، وكان هذا الأساس لكل أشكال كراهية الأجانب التي تتربص بكل مجتمعات الكرة الأرضية. وفي سياق متصل، يسعى الباحث الجزائري بوحنية قوي، إلى الإجابة عن سؤال رئيس: كيف يمكن قراءة مشروع قانون مكافحة الجريمة وسط تنامي مشاعر الكراهية تجاه الجالية المسلمة في فرنسا؟
ففي ضوء التفجيرات الإرهابية التي شهدتها فرنسا العام 2015 فجرت وسائل الإعلام الأوروبية النقاش حول مسألة هوية المهاجرين وأصولهم ودرجة اندماجهم في أوروبا؛ وتنادت الأصوات اليمينية من جديد لضرورة استحداث قانون جديد يرتبط بالجنسية وتعقب الإرهاب والإرهابيين، وما تولد لاحقا في مشروع قانون للاستخبارات الجديد في فرنسا. ويعتقد الرافضون لمشروع القانون أنه ربما يطلق يد الاستخبارات والأمن للتضييق على الحريات العامة بدعوى مكافحة الإرهاب، لكن الحكومة الاشتراكية رفضت تلك الاتهامات، وأكدت أن مشروع القانون فرضته التحديات الأمنية التي تواجهها فرنسا، وأن هناك ضمانات دستورية وقانونية تكفل الحريات. الكتاب اشتمل على دراسات أخرى، قاربت موضوع الإسلام في أوروبا، من زوايا مختلفة، وفي بيئات أخرى إضافة إلى فرنسا، ساعية إلى تكوين رؤية أكثر علمية عن قضية لم تعد هم المسلمين وحدهم، بل تجاوزتهم إلى المجتمعات التي يعيشون فيها، ويكونون جزءا من نسيجها المتنوع.
9:8 دقيقه
«الإسلام في أوروبا» بين إشكاليات الاندماج وتحديات الإرهاب
https://aawsat.com/home/article/662676/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%C2%BB-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8



«الإسلام في أوروبا» بين إشكاليات الاندماج وتحديات الإرهاب
كتاب جديد لمجموعة باحثين من إصدار مركز «المسبار»


«الإسلام في أوروبا» بين إشكاليات الاندماج وتحديات الإرهاب

لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة