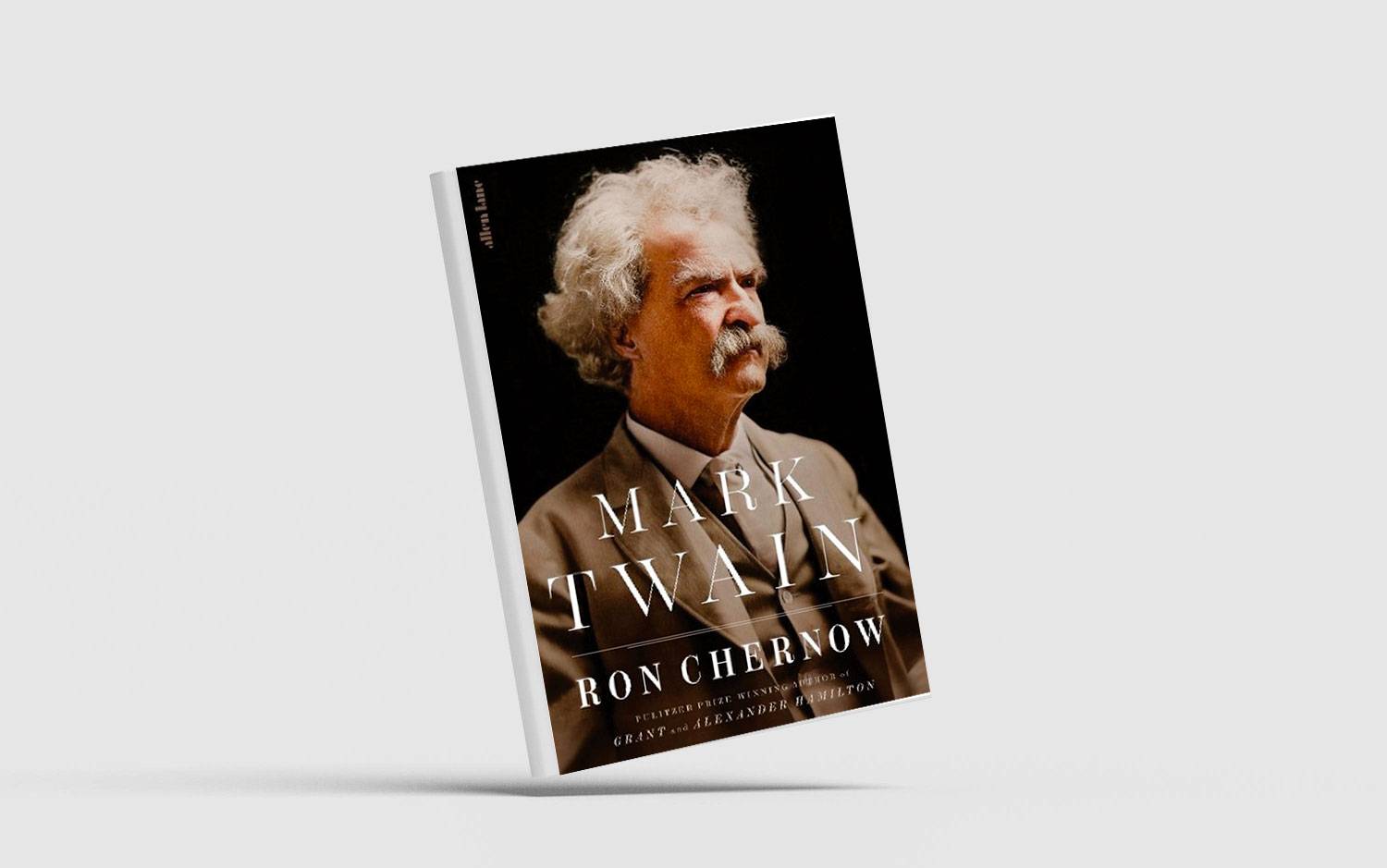حافة إنسانية حرجة تلعب على وترها المجموعة القصصية «همس» للكاتب خالد عاشور، والصادرة حديثا عن الهيئة العامة للكتاب بالقاهرة، حيث يطل المأزق الإنساني في أقسى لحظاته تهميشا وقمعا، سواء على مستوى الداخل جسدا وروحا، أو على مستوى الواقع بكل ضغوطه القاهرة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وغيرها.
ينجح الكاتب في تجسيد هذا المأزق والتعبير عنه، عبر أبطال قصصه الذين يختارهم بعناية شديدة من ثقوب وفجوات الواقع والحياة. كما ينجح بحذق لا يخلو من مهارة ما، في تنويع وتدوير مدارات السرد والحكي وحركة الضمائر، بين أنا المتكلم (السارد) وحركة الـ«نحن» والـ«هم» كمرآة جماعية تعكس صورة الواقع، وفي الوقت نفسه تعكس صورة الشخوص أبطال القصص، وتصوير أحوالهم وصراعاتهم البسيطة العادية مع الواقع والحياة، ونبش ما يفور داخلهم من صرخات مكتومة، تشبه رجاء العيش الأخير، أو الشهوة الأخيرة، وسط ركام من الذكريات المرة والأماني المعلقة دائما في حبال النسيان.
وتتحرك هذه الرؤية في المجموعة عبر مقومين فنيين يحكمان فضاء القص؛ المقوم الأول هو الاستخدام العفوي لآلية التقمص، فمن خلال هذه الآلية يدفع الكاتب بأبطاله إلى صدارة المشهد دراميا، محققا نوعا من التماهي الشفيف، بين الأنا الساردة، وهوية المسرود عنهم، وهو تماهٍ يكسر حيادية الراوي، ويصل في بعض القصص إلى حد الالتصاق الحميم بمآسي الشخوص وعوالمهم الكئيبة المفجعة، أيضا يحقق شكلا من أشكال الذروة الفنية، تنحل فيها المسافة بين الرمز ومرموزه، ويصبحان عجينة واحدة، دون فواصل بين الداخل والخارج، كما في قصة «عصفوران»، على نحو خاص، وبتفاوتات ما في قصص: «همس»، «نظام»، «قهوة والي»، «غرفة سلمى».. فمن سطوة الجسد المقموعة تحت وطأة الفقر والجوع والعوز، وافتقاد أبسط مقومات الحياة في غرفة تشبه القبر تحت «بير السلم»، تتكدس فيها البطلة مع زوجها خادم البناية، وطفليها في قصة «همس»، حيث الظلام والهمس هما اللغة الوحيدة المسموح بها في لقائهما العاطفي الحميم، ثم الارتطام بسقف الخطيئة، وصراخ النشوة مع الساكن الشاب، الذي يوقعها في حبائله وهي تنظف شقته الواسعة الوثيرة، وهو الصراخ الذي لا ترى فيه البطلة سوى براءة الحلم ومعنى الحياة الحقيقي، المعطل المسروق من طوايا الجسد والروح معا، وتنتهي حياتها على يد زوجها وهو يطبق على رقبتها، حتى تلفظ آخر صرخة للحياة في جسدها المنهك تحت سياط الفقر والجوع.
من هذه الحافة الحرجة إلى حافة العيش في سطوة عباءة السلطة، واستحضار هالاتها كماض لا يكف عن التناسل والتبرير وإصدار الأوامر، وهو ما يتجسد في شخصية بطل قصة «نظام»، رجل السلطة المتقاعد، الذي تحول إلى كاتب «عرضحالجي»، مقتطعا مساحة من الخلاء أمام أحد أقسام الشرطة، ويجلس أمام منضدة متهالكة، واضعا على الحائط خلفه لافتة دالة «الشرطة في خدمة الشعب»، بينما طيلة الوقت لا يكف عن الأمر والنهي وتوزيع الشتائم على الناس للناس، متوهما أنه القائد، وأنهم مجرد قطيع في طابور يقوده، ويعلمهم النظام وطاعة الأوامر.
هناك أيضا التوظيف الواسع والعميق لرمزية السلطة، المجسدة في محاكمة الرئيس المخلوع (محاكمة القرن)، والتواشج بينها ورمزية القفص والعصافير، وانسحاب البطل الفقير من الحياة، بعد صراع مرير مع المرض في مستشفى حكومي، وهو الذي لا يملك من الحياة سوى غرفة بالكاد تصلح للمأوى فوق سطح البناية، وتزامن لحظة موته مع علمه من ابنته الوحيدة بدخول الرئيس المخلوع قفص المحاكمة، وهي اللحظة نفسها التي يغادر فيها العصفوران حافة السطح، ليحلقا بحبور طليق في الفضاء. وكذلك «طارق» الشاب الحاصل على تعليم جامعي، والذي تحت وطأة البطالة يعمل نادلا بمقهى شعبي شهير بمدينة الإسكندرية، وسعادته الغامرة حين يناديه سائق الميكروباص، «اركب يا باشا»، اللقب الذي اعتاد طارق أن يرد به على طلبات الزبائن بالمقهى، وكأنه منحة أو هدية شخصية يستردها من صخب الحياة، تخفف عنه أعباء العمل، وهو عائد إلى زوجته وطفلته في الصباح الباكر، بعد أن أنهى ورديته الليلية بالمقهى.. ثم «سلمي»، وغرفتها الوحيدة التي تغلقها عليها طيلة الوقت، ولا صوت لها سوى صراخها المحموم بكوابيس الليل، بعد أن هرب زوجها وأخذ معه الأولاد، وتركها تصارع الحياة فوق حافة الفقر والجنون، في بناية شعبية غريبة الأطوار، لكنها تشكل ملاذها الوحيد، من عبث الحياة في الخارج.
إنه إذن صراع الأضداد، بين الهمس والصراخ، بين الفقر ويسر الحال، بين الجوع والشبع، بين فورة الجسد وتشققات الروح، يبرز كمقوم فني آخر، في فضاء هذه المجموعة، كاشفا عن وجه لاهث ومعتم من وجوه الحافة الحرجة، لكنه صراع عقيم، أحادي، لا يفضي سوى لتصالح زائف، مبتور ومشوه، بين واقع طاغ، وصراعات شخوص، تحلم بلحظة دفء وأمان في المستقبل. ومع ذلك، تنفك هذه الأضداد من مظانها المعرفية التقليدية، في عدد من القصص، فلا يصبح الهمس نقيضا للصراخ فحسب، وإنما مرادفا للخوف، وانكسار الروح والصوت. كما تتسع دلالاته، فيبدو بمثابة الزمن الهارب من واقع الشخوص وحياتهم الفقيرة القاسية.
ورغم ذلك، تقع بعض القصص في سذاجة الرمز ومجانيته، أو التكرار والتماثل النمطي بين ظاهرتين اجتماعيتين، خاصة القصص التي تدور في فلك السجن، أو يكون أبطالها من رجال الشرطة، مثل قصص «الرئيس» و«حرية» و«قرن غزال»، التي يتم فيها التماثل بين حيرة الراوي، الذي توقعه مصادفة ذهابه إلى عمله في الصباح الباكر مع سائق «ميكروباص» وصبيه، وهما يتعاطيان المخدرات في نشوة مدمنة، ثم هرعه لمغادرتهما، بعد أن انتابه الخوف من «مُدية» يلمع نصلها بحدة في يدي الصبي، تذكره بوضعية مديره المتسلط الملتحي في الشغل، الذي يشكل له مُدية أخرى، يتخيل أنها دائما مشرعة في وجهه. كما تتسلل نبرة طفيفة أحيانا من الوعظ في طوايا الحوار في بعض القصص، تجره إلى منطق تبريري، بلا مبرر فني، مثلما يقول الكاتب في قصة «إعلان موت شخص يدعى صديقي»: «نحتاج أحيانا إلى وجود الآخر في حياتنا، لأنه دليل وجودنا، ونفر من وجوده أحيانا لأنه ينفي وجودنا». أيضا هناك إفراط وغلو في استخدام الرمز، الأمر الذي يحد من قوته الدلالية، ويجعل الرمز نفسه مجرد إشارة عابرة للسخرية.. مثل الغلو في رمزية الكلب الأجرب، الذي كان بطل قصة «نظام» لا يكف عن مطاردته وضربه بالعصا الغليظة، حتى يبعده عن المكان، فالكلب حين يغادر البطل الحياة، ويغيب عن المكان لا يكتفي بمحو لافتة «الشرطة في خدمة الشعب» التي كان يعلقها بطل القصة على الحائط خلف ظهره، فبعد أن محا معالمها، وهو يحكها بأعضائه التي تنزف دما، يتأملها، ثم يرفع قدميه ليبول عليها. أتصور أنه كان من الأجدى فنيا انتهاء القصة عند طمس اللافتة بدم الكلب، حتى تتسع رمزية الإحساس بالظلم، فتبدو الحيوانات وكأنها لم تسلم من بطشها أيضا.
12:57 دقيقه
الحكي من فوق الحافة الحرجة
https://aawsat.com/home/article/357536/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%AC%D8%A9



الحكي من فوق الحافة الحرجة
المصري خالد عاشور في مجموعته القصصية «همس»

غلاف «همس»
- القاهرة: جمال القصاص
- القاهرة: جمال القصاص

الحكي من فوق الحافة الحرجة

غلاف «همس»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة