اقتربت البوكر.. تفصلنا ساعات قليلة عن إعلان الفائز بجائزة الرواية العربية لهذا العام، التي تعلن 6 مايو (أيار)، وقد احتلت رواية السوداني حمور زيادة «شوق الدرويش» عن دار العين، مكانها في القائمة القصيرة بوصفها «تناولت منمنمات النفس البشرية في صراعها مع صرامة المقدس». ونالت نصيبا كبيرا من النقد بعد فوزها عام 2014 بجائزة نجيب محفوظ التي تمنحها الجامعة الأميركية بالقاهرة، والآن ونحن قاب قوسين أو أدنى من إعلان الجائزة الكبرى، هل تنال الرواية الضخمة «460 صفحة» الجائزة؟
يعطينا عنوان الرواية، مكثف المعنى والدلالة، مفتاحا تأويليا عن النشوة الصوفية في الحب. وبشكل عام جاء العنوان منسجما مع مسارات المحكي. واتخذ زيادة من مقولة ابن عربي «كل شوق يسكن باللقاء، لا يعول عليه» عتبة دفاعية عن نصه؛ فمنذ بداية الرواية خلع الروائي على بطليه عباءة المثالية وأعطى القارئ لمحة عن الدافع المحرك وراء شخصية البطل العبد «بخيت منديل» الذي يتحرك وفقا لعشقه لليونانية السكندرية «ثيودورا» الراهبة ضمن بعثة تبشيرية. تدور الأحداث في مناطق مختلفة من السودان وتعكس أحوالها في بدايات القرن التاسع عشر وتحديدا في الفترة التي سبقت الثورة المهدية وحتى موت مهدي الله. للوهلة الأولى تخطف الرواية أنفاس القارئ بلغتها والمشاهد العنيفة التي تجسدها ما بين أسر وقتل وعبودية ووحشية وخوضها لتلك الفترة التاريخية المجهولة، لكنه تدريجيا يشعر بأنه ينزلق مع البطل في متاهة من الشخصيات والأحداث.
قد تذكرنا «شوق الدرويش» برواية ويليام فوكنر «وردة لإميلي» 1939 حيث تتطلب الرواية القراءة المتكررة عشرات المرات فهو يدفع القارئ إلى توقعات مسبقة في اضطراب مدبر يحتاج إلى قراءة مزدوجة ما بين بداية الرواية وسير أحداثها وخاتمتها.
ويبدو جليا أن الروائي أراد أن يكون الأساس الصلب الواضح في الرواية هو «الخيط العاطفي» والعلاقة التي تتكشف تدريجيا ما بين الأحداث الصاخبة، فيتبين أن قصة العشق ما هي إلا عشق أفلاطوني غير منطقي خاصة في الحوارات التي تدور بين البطل ومعشوقته، فلا نعرف أبدا هل هو عشق متبادل أم أنها شفقة من الجميلة اليونانية على «العبد القبيح»؟ على حد وصف الراوي، روحه بيضاء كنور القديسين. تشفق عليها أنها محبوسة في جسد أسود غليظ الشفتين، قبيح كمدينة أم درمان، لكن روحه مشرقة كالإسكندرية (ص 246) مما يرهق القارئ بينهما وبين عشرات الشخصيات التي يرغب بخيت في الثأر منها لأجل محبوبته التي لم تبادله الحب قط!
ويبدو أن رغبة المؤلف الجامحة في تنوع محفله السردي أفلتت منه زمام اللعبة السردية، فقام بتكديس اقتباسات من القرآن الكريم والإنجيل وكتابات ابن عربي والحلاج، والاستعانة بـ«السرد، والشعر، والحوار، والرسائل، والمذكرات، ومقاطع أغان تراثية مصرية وسودانية».
تتحرك الرواية في الزمن إيابا وذهابا، فمنذ بدايتها نجح زيادة في أن يأخذنا بإيقاع مليء بالإثارة والتشويق إلى أحداث متواترة في حياة البطل تبدأ منذ دخول المصريين أم درمان والفوضى التي صاحبت سقوط دولة المهدي، وتحفزه للانتقام ممن قتلوا معشوقته بعد خروجه من السجن «أتتهم الحرية على بوارج الغزاة وخيولهم في سبتمبر 1898 مع دخول الجيش المصري للبلاد. انكسرت دولة مهدي الله». لكنه وقع في فخ الترابط الزمني للرواية لا ندري تحديدا ترابط الأحداث التي وقعت على مدى 17 عاما ما بين خروج البطل من السجن عام 1898 في البداية لينتقم لأجل «ثيودورا» أو «حواء»، ففي منتصف الرواية يذكر المؤلف نتفا من مذكرات «ثيودورا» في عام 1881 بعد أن تم استرقاقها على يد إبراهيم ود الشواك. ونجح الروائي في استغلال تلك المذكرات (ص: 255 إلى 258) في استعراض الحياة السودانية آنذاك بعيدا عن السرد التقليدي للتاريخ. وهنا، تضعنا الرواية في مفارقة الفهم التاريخي لعمل تدور أحداثه في الماضي ويستلهم أحداثا وشخصيات حقيقية، وبين الاستمتاع بالرواية باعتبارها حكاية شعبية أسطورية؛ حيث ضجت الرواية بعدد غير مترابط من المؤشرات الزمنية «منذ 7 أعوام، وبعد أربعة شهور..».
ووقع الروائي في فخ تقنية «التلاعب بالتعاقب الزمني» التي استهلكها في كل الفصول وأتصور أنه لا يفترض أن ينهك القارئ في هذا الجهد العقلي لإعادة بناء حكايته عشرات المرات كي تكتمل القصة أمامه! فقد اختار أن يخبرنا بداية قصة حب بطله والقديسة «حينما رأها تسير في بيت إبراهيم ود الشواك الذي استعبدها» في صفحة 406، أي قبل نهاية الرواية وكنت أفضل أن أعرف سر ولعه بها في الصفحات الأولى كي أستطيع أن أفهم وأقتنع بمشاعره وتصرفاته وسر رغبته في الانتقام! وكل هذا الهيام في الحوارات بين البطل وجميع شخصيات الرواية حول الحب والعشق الذي أنهك القراء دون أن يقنع القارئ بقصة الحب المتأججة، ربما لأنه استطاع أن يتعرف على صوت الروائي مثل «الملقن» المسرحي للممثلين، فتنتابك رغبة عارمة في هجر الرواية.
كما أنه روى لنا في الثلث الأول للرواية كيف كانت نهاية البطلة ثم دخلنا في متاهة الأحداث والتفاصيل التي لا تنتهي حتى أعاد علينا قبل نهاية الرواية في الصفحات 444 إلى 446 قص النهاية الدرامية للقديسة ثيودورا، وأعاد الكثير من الحوارات بينها وبين بخيت في محاولة لصبغ الرواية بتقنية «بلاي باك» السينمائية لكنها كانت في غير محلها.
يؤخذ على الرواية بعض المماطلة في الثلث الأخير من الرواية ومنها المشهد الذي يصور فيه البطل مع سيده المصري وهما يقضمان القصب ويدور بينهما حوار يخوض به في تفاصيل مملة حيث يستمر الخوض في تفاصيل علاقة السيد بزوجته وكيف أنه كان يهرب منها ليجالس العبد يقرئه الشعر ويتحدث معه عن العشق وقيس وليلي.
لم تقدم الرواية نسيجا قصصيا جديدا فهي تشبه رواية الكاتب الفرنسي ألكسندر دوماس «الكونت دي مونت كريستو» الكلاسيكية في تناولها لحياة البطل المظلوم المقهور الذي سجن وأبعد عن حبيبته وظل سنوات ليفكر في الانتقام ممن زجوا به إلى السجن، هكذا كان حال بخيت منديل الذي ظل طوال الرواية يهدف لقتل طرائده الست، وظل يراوغ القارئ بما يظنه بخيت من قصة عشق وهمية بين القديسة و«يونس ود جابر» استطال في سرد تفاصيل مبهمة عنها وتمادى في الحوارات الغامضة بين البطل والبطلة حول ذلك الغريم وكأنه لغز، يعطي مفتاحه للقارئ في (يونس هو مهربها) ص 416، ثم يوالي فك طلاسم ذلك اللغز بأنه أيضا أبلغ عنها وكان سببا في مقتلها على يد سيدها «إبراهيم ود الشواك» أراد الروائي أن يزيد من درامية وملحمية روايته فاختار أن يجعل البطل هو من قام بدفن معشوقته، وأنهى الرواية بيأس العبد العاشق من الحياة بعد أن قتل بعضا ممن قتلوا محبوبته إلا أنه لم يقتل «يونس ود جابر» الذي كان السبب في قتلها، وتنتهي الرواية برغبة البطل في أن ينهي حياته وأن يسلم نفسه لينتهي على مشانق السوق.
زج الروائي بعدد كبير من الشخصيات منهم: جوهر (رفيق بخيت في السجن)، وإدريس النوباوي (كان يجلس ليسامر بخيت تحت نصبته في السوق)، كما أن بعض الجمل الفلسفية على لسان بخيت الذي وصفه بالجاهل لم تبد منطقية، مثل: «فقط حين نكف عن الاحتفاء الزائف بالحياة نعرف قيمة الموت» ص 331.
ورغم ما يحسه القارئ من شكسبيرية مصطنعة ما بين صفحات الرواية، فإن «شوق الدرويش» لها قاموسها اللغوي وشبكتها الدلالية التي انفردت بها لتعكس وحدات اجتماعية وتاريخية وعادات لغوية سودانية قديمة في الحكايات والغزل والتهديد والتحية والأفراح وغيرها. وجمل السرد كانت تتراوح بين جمل رومانسية وأخرى تأملية تحليلية تحاول مد الرواية بالحياة والإدهاش، ولعب الحوار في بعض المشاهد دورا بنائيا هاما في عكس العنف الداخلي للشخصيات.
فقد برع زيادة في غرس القارئ في المحيط الاجتماعي الخاص بذاك الزمان والمكان، واستطاع أن يضفي على نصه صفة «الملحمية» فاستعان بالاستعارة الموسعة والاستعمال المتعمد للمفارقة في عناصر الصوت والكلمة والصورة والإيقاع والتيمة (انكسار العبودية، لهفة العاشق، عذاب الفقر ووحشيته، الصراع الديني والسياسي، صراع البقاء)، ويتجلى ذلك في سرده لما حل بأهالي السودان من جوع شديد عبر حكاية شخصية «مريسيلة» التي قدمها لنا في بداية الرواية باعتبارها المرأة القوية التي يلجأ إلى البطل فور خروجه من السجن وهي التي تتكفل به وتحميه حتى يتمكن من الانتقام من قتله معشوقته. فكشف لنا عن سر جبروتها في منتصف الرواية. إنها «مريسيلة» التي أرادت أمها بيعها مقابل طاستين من الذرة لكنها لم تفلح، فأراد رجل أن يأخذها لكي يأكلها أولاده، وبعد أن طردتها أمها لم تعرف إلى أين تذهب فعادت للمنزل لتجد أمها أكلت أخيها الرضيع. «في الغرفة اليتيمة وجدت أمها على الأرض تبكي ملوثة بالدم. وبقايا طفلها الوليد في قدر نحاسية» ص 239.
لكن حلاوة اللغة شابها بعض العطب في استخدام الاستعارات والتشبيهات، مثل: «رائحة بخيت التي كقرحة أليفة»، و«حليب البلابل»، وغيرها وبعض التشبيهات كانت فظة وغليظة التي كان استخدامها مع توظيف الجنس في الرواية مقززا، يجعلك تصل لحد كراهية المجتمع السوداني.
على مستوى المتخيل الحكائي، كنت أتوقع كغيري من القراء أن تكون نهاية البطل ومعشوقته مغايرة لحتميات الواقع كما كانت الرواية توحي. صرح زيادة في أكثر من محفل أنه «مجرد حكاء يريد أن يروي حكاية قد تكون مسلية أو لا»، وقد وجدها عدد من القراء مسلية لكنني ضمن الزمرة التي لم تتسلَ، ولم تجد احتفاء النقاد والبوكر بها مستحقا.
الروائي السوداني حمور زيادة بنى عالمًا «شكسبيريًا» أضعفته الحبكة
«شوق الدرويش».. في القائمة القصيرة لجائزة «البوكر العربية» التي تعلن اليوم
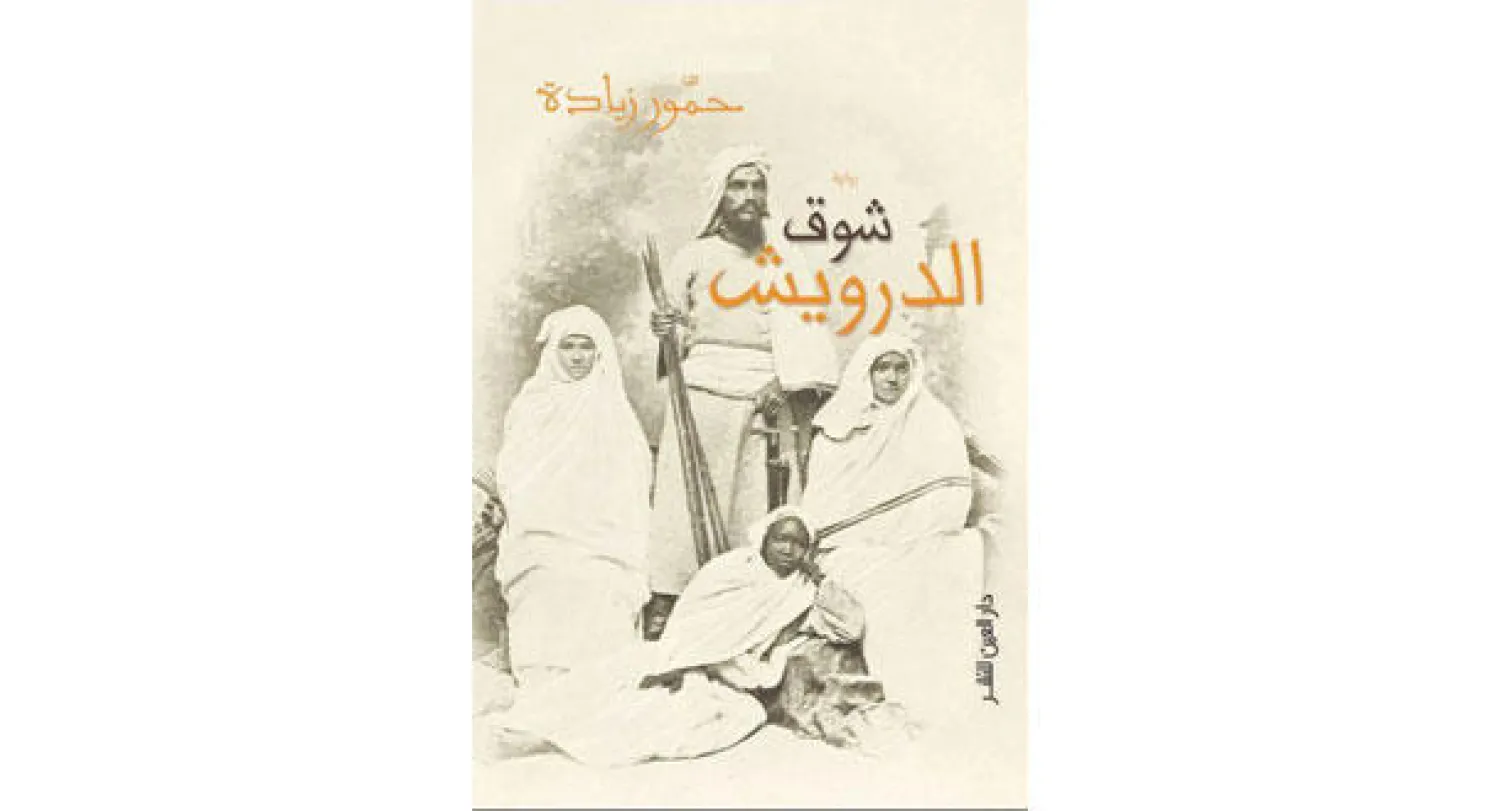

الروائي السوداني حمور زيادة بنى عالمًا «شكسبيريًا» أضعفته الحبكة
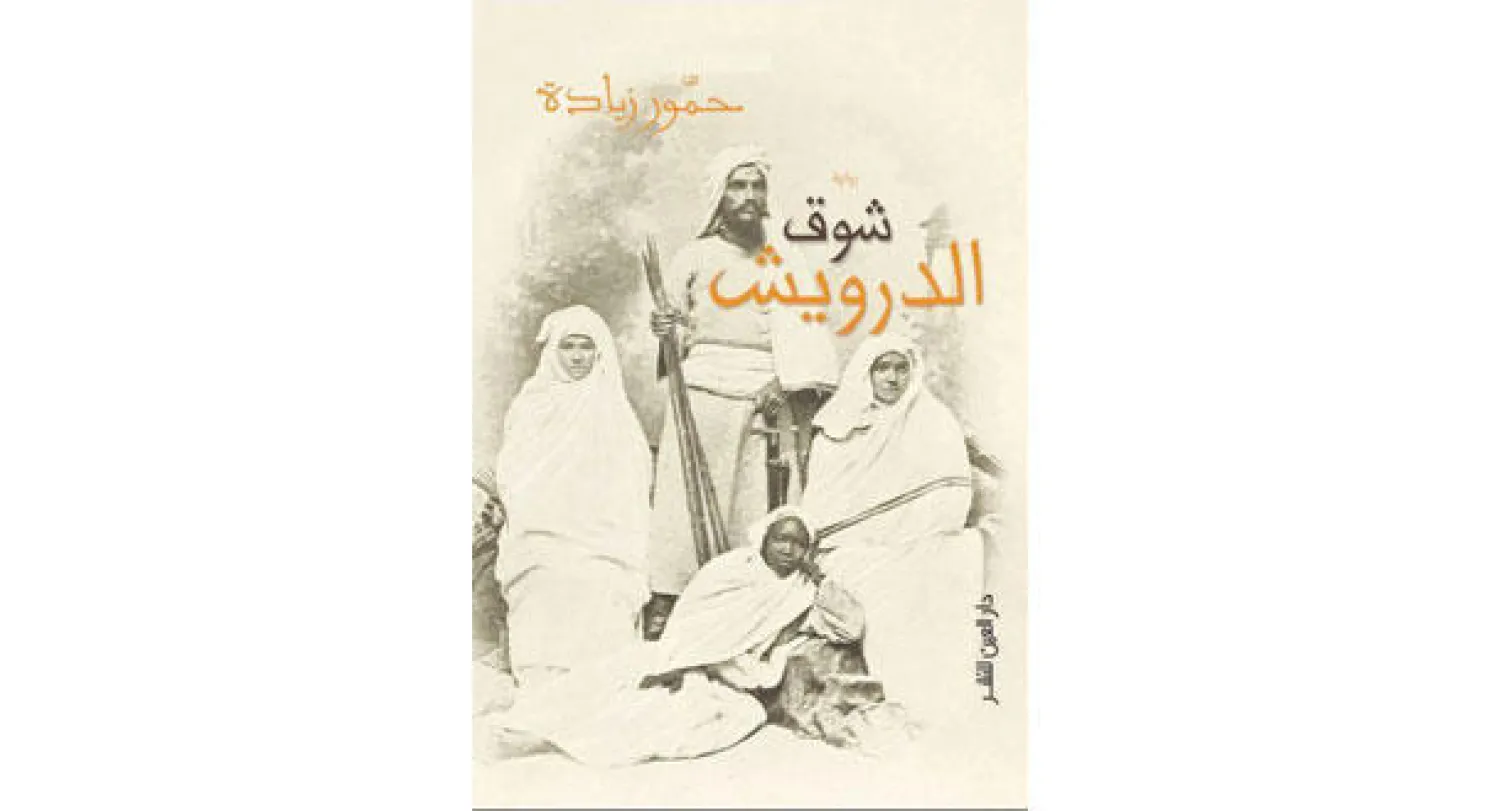
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة









