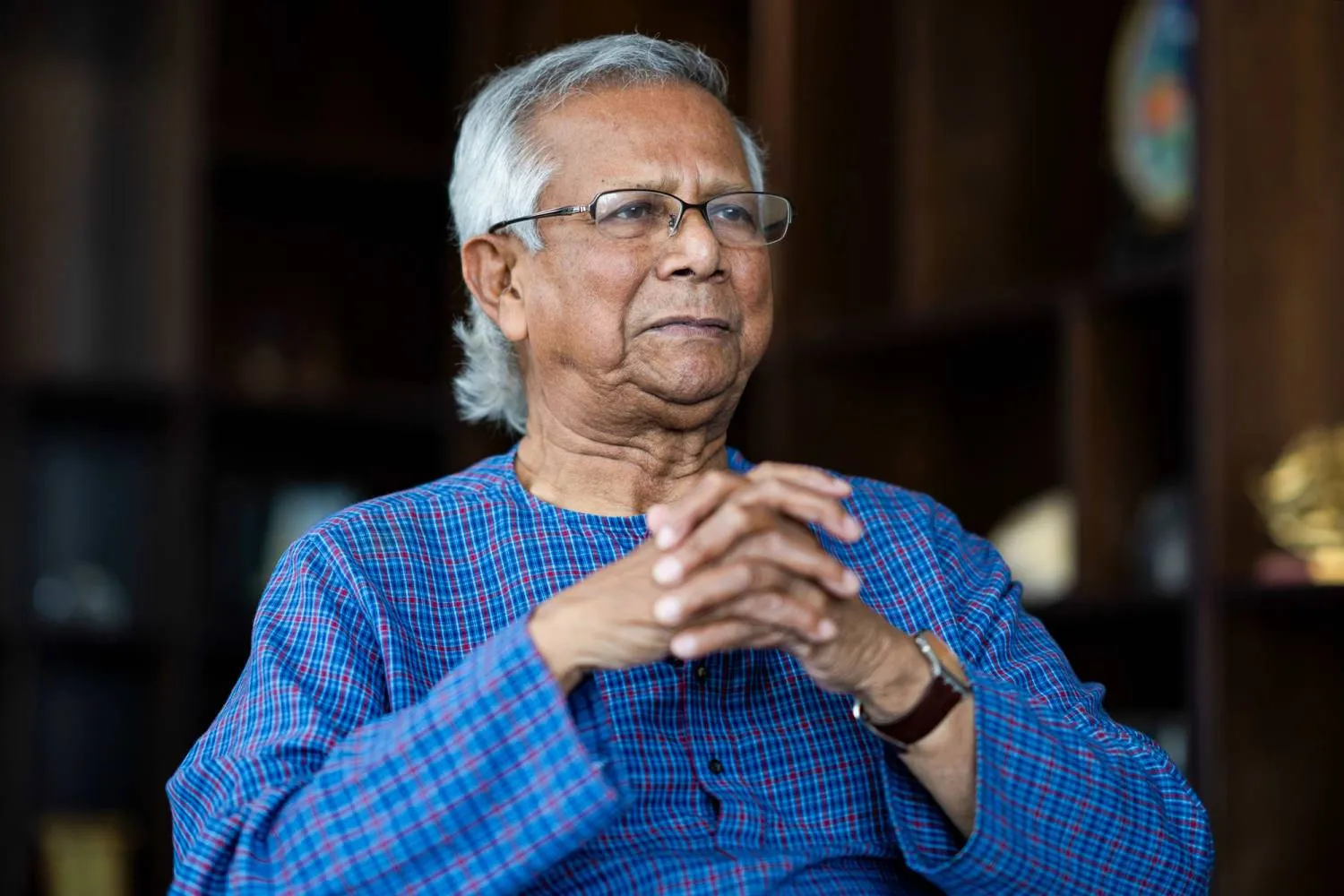من أسقط العاصمة اليمنية صنعاء بيد المتمردين الحوثيين؟ سؤال يردده اليمنيون منذ 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنه لم يعد بلا جواب بعد أن اتضحت الصورة رويدا.. رويدا، وتكشفت بعدها اليد التي سلمت عاصمة بلدهم إلى جماعة مسلحة، فظهور القيادات العسكرية والأمنية والحزبية الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح بأسمائها ومسلحيها في صنعاء و5 مدن أخرى، يكشف عن قدرة صالح على بناء تحالف جديد مع من قاد ضدهم 6 حروب، وكان المستهدف من هذا التحالف خصومه الذين أسقطوه من على كرسي الحكم عام 2011. ورغم ذلك، فإن صالح ظل ينفي وجود هذا التحالف ويعده ضمن محاولات خصومه لتشويه صورته.
لطالما ردد صالح عبارته المشهورة «الحرب من طاقة إلى طاقة»، وقد نجح في ذلك إلى حد كبير، فقد تحولت معظم مدن الشمال إلى مناطق عنف سقط فيها قتلى وجرحى، ويقابل ذلك تمكن صالح الذي يوصف بأنه «مراوغ وماكر» من تضليل الرأي العام والمجتمع الإقليمي والدولي بخروجه من السلطة، لكنه ظل يمتلك زمام السلطة عبر منظومة الحكم التابعة له من قيادات عسكرية وأمنية وحزبية موالية له كان يديرها بعيدا عن سلطة الدولة من خلال غرف تحكم مركزية كان يستخدمها أثناء حكمه، سواء في منزله المحصن بالضاحية الجنوبية للعاصمة صنعاء أو من مسقط رأسه في مديرية سنحان حيث احتفظ بمعسكرات في منطقة «ريمة حُميد»، وتضم جميع أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ورفض تسليمها الدولة. ويقول نجل رئيس سابق في حديث جانبي مع «الشرق الأوسط»: «في أحد لقاءاتنا مع صالح، نصحناه بترك العملية السياسية وترك الشعب يختار طريقه، لكنه رفض وقال لنا: (علي وعلى أعدائي)».
لم يعد صعبا التوصل إلى حل لغز سقوط صنعاء، فشهادات كثير من العسكريين والجنود تؤكد أن السلطات العسكرية والأمنية سلمتها للحوثيين وبتوجيهات رسمية من قيادة وزارة الدفاع، التي كانت تؤكد مرارا أن الجيش مؤسسة محايدة، فيما يعتبر الحياد في هذه الظروف نوعا من الخيانة كما يقول الخبراء العسكريون، فالسيطرة على العاصمة صنعاء وقبلها سقوط مدينة عمران بيد الحوثيين، كانت بصمات صالح وأنصاره تظهر فيها، مستندا إلى منظومته الإعلامية والمالية والعسكرية والقبلية الذين كانوا يظهرون بأسمائهم وأسلحتهم لمساندة المتمردين الحوثيين. وقد أثبتت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن ذلك، إذ يسعى المجلس حاليا إلى معاقبة زعماء هذا التحالف الذين حددتهم اللجنة بـ5 أشخاص، يتصدرهم علي عبد الله صالح ونجله أحمد الذي يعمل سفيرا لبلاده لدى الإمارات، وعبد الملك الحوثي وشقيقه عبد الخالق، إضافة إلى القائد الميداني للحوثيين عبد الله الحاكم.
* هادي لغز محير
* لا يزال موقف الرئيس عبد ربه منصور هادي من التحالف بين صالح والحوثيين لغزا محيرا، فهناك روايات متعددة حول صمته الأولي من سيطرة الحوثيين على صنعاء وعدم اتخاذه قرارات حازمة ضد من أسقط صنعاء واقتحم ونهب معسكرات الجيش بما فيها من الأسلحة الثقيلة. وعلى الرغم من أن خطاباته فيها الكثير من الوعيد والهجوم على الحوثيين، لكنها تبقى حبرا على ورق، كما يقول كثير من المحليين. فوزير الدفاع محمد ناصر أحمد علي، المقرب من هادي، أصدر التعليمات للجيش بتسليم المعسكرات للحوثيين بصنعاء، وهناك روايات أخرى مفادها أنه (هادي) ربما هو نفسه ضمن هذا التحالف الذي أسقط هيبة الدولة. ويلاحظ في خطابات هادي أنه كان دائما ما يردد مقولته الشهير: «إن محافظة عمران خط أحمر، وصنعاء خط أحمر»، لكن الحوثيين تجاوزوا هذه الخطوط ووصلوا إلى بوابة قصره الرئاسي بصنعاء وذهبوا إلى أبعد من ذلك عبر مد نفوذهم إلى مدن ذمار والحديدة وإب والبيضاء وحجة.
لقد كان وزير الخارجية اليمني، جمال السلال، واضحا عندما اتهم أنصار صالح بمساعدة المتمردين الحوثيين للسيطرة على العاصمة صنعاء، فقد أكد في كلمته أمام الدورة الـ69 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر الماضي: «ما كان لذلك أن يحدث لولا الدعم السياسي والتنسيق اللوجيستي من قبل بعض عناصر النظام السابق». وتؤكد الإحصاءات الخاصة بالمعسكرات والمنازل التي تم اقتحامها من قبل الحوثيين وقوف صالح وراء ذلك، فالمعسكرات والمنازل كانت لخصوم صالح، أبرزهم الجنرال علي محسن الأحمر، ورجل الأعمال حميد الأحمر، إضافة إلى مقرات ومنازل قادة حزب الإصلاح الذي قاد ثورة الشباب عام 2011 التي نجحت في إسقاط صالح من الحكم. وتشير الإحصاءات الخاصة بما تم اقتحامه ونهبه من قبل الحوثيين، إلى رصد أكثر من 211 مقرا من المنشآت الحكومية والعسكرية والخاصة، منها 29 مقرا لحزب الإصلاح، و62 منزلا لقياداته أو الموالين له، إضافة إلى 26 مؤسسة تعليمية، و8 مؤسسات إعلامية. وفي المقابل، تركت معسكرات الحرس الجمهوري المنحل وألوية العمليات الخاصة كما هي ولم يتم اقتحامها أو الاقتراب منها، ويعرف عن هذه المعسكرات ولاؤها الكبير لأحمد نجل صالح الذي كان قائدا لها قبل تعيينه سفيرا لدى الإمارات.
ورغم الشواهد الكثيرة التي تثبت تحالف الحوثيين مع صالح، فإن الناطق باسم «المؤتمر» والأحزاب المتحالفة معه ينفي وجود هذا التحالف، واعتبر الناطق الرسمي للحزب عبده الجندي، أن ما حدث بصنعاء كان بين طرفين متصارعين هما الحوثيون وحزب الإصلاح، موضحا أن التحالف مع الحوثيين هو مجرد «أخبار واتهامات ووقائع مكذوبة ولا أساس لها من الصحة وتهدف إلى الإساءة إلى (المؤتمر الشعبي العام) وقيادته ومواقفه»، لكن قيادات محلية معارضة للحوثيين، في صنعاء، ومحافظات الحديدة وإب والبيضاء أكدت وجود قيادات من أنصار صالح وجنود من الحرس الجمهوري الذي كان يقوده أحمد نجل صالح، في صفوف الحوثيين، وأغلبهم يسيطرون على المقرات العسكرية والحكومية في صنعاء، فأغلب المسلحين فيها يدينون بالولاء لصالح ونجله أحمد الذي يعتبرونه الرئيس المقبل لليمن، ويضعون صوره على بنادقهم وعرباتهم.
* تسليم صنعاء
* يشرح الخبير العسكري العميد محسن خصروف أن «علي عبد الله صالح ضالع في دعم الحوثيين لإسقاط صنعاء وبقية المدن، من أعلى الرأس إلى أخمص قدمه»، ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «كان لصالح شخصيا وقياداته العسكرية السابقة من الحرس الخاص وقيادات من (المؤتمر الشعبي العام)، مخطط تم إعداده منذ سنتين، ولهم علاقة بما حصل في عمران واقتحام صنعاء وبقية المدن ونهب أسلحة الجيش، وقد كان الحوثيون مجرد غطاء لصالح وأنصاره». وأوضح أن مؤشرات هذا الدعم يكمن في «المشاركة المباشرة لقيادات عسكرية وأمنية وبرلمانيين بأسمائهم ومراكزهم في حصار صنعاء، وهم معروفون للجميع». وحول سهولة دخول الحوثيين وسيطرتهم على المدن، يقول العميد خصروف: «صنعاء والمدن الأخرى لم تسقط، ما حدث ببساطة أنه جرى تسليم وتسلم، عبر اتفاق مسبق بين القيادات العسكرية والأمنية والسياسية، وما حدث من معارك أثناء اقتحام صنعاء كان بهدف التغطية على ذلك، لكن مع الأسف كان الضحية الجنود والمدنيين الذين سقطوا فيها حتى تكتمل التمثيلية الإجرامية». وعد خصروف ما يحدث في اليمن «عملية معقدة، وهي نتاج اتفاق محلي وإقليمي ودولي، حيث تم تعطيل سلطات الدولة بفعل فاعل، وصدرت الأوامر بتحييد قوات الجيش والأمن وترك الميدان للحلف الحوثي الصالحي، ليتسلموا المدن». ويتابع خصروف: «لا يفترض أن يكون الجيش محايدا، ولا أن يكون منحازا إلى أي طرف، بل عليه أن يوقف ما يهدد الأمن القومي للبلاد الذي تم تجاوزه خلال هذه الأحداث، فالجيش من واجباته إيقاف الصراع بين طرفين أو فئتين، ويضرب بيد من حديد الجماعات المسلحة التي تنشر العنف في أي منطقة بالبلاد».
ويرجع الخبير العسكري سبب هذا التحالف بين صالح والحوثيين إلى رغبة الأول في العودة للحكم، ويقول: «كان الهدف الرئيس من هذا الحلف هو العودة للحكم، لكن المتضرر المباشر من ذلك هي العملية السياسية التي تم إحباطها وإعاقتها وخلط أوراقها، إضافة إلى أن هذا التحالف يستهدف جهود الدول الشقيقة والصديقة، خاصة المملكة العربية السعودية، التي رعت العملية السياسية ودعمت انتقال السلطة». وأشار إلى أنه ليس في صالح اليمن استمرار هذا التحالف الذي يقود البلاد إلى «مستقبل مدمر» ويخلق جماعات محلية مضادة كما حدث في محافظتي البيضاء، وإب. وبحسب العميد خصروف، فإن «تمدد الحوثيين كان له رد فعل لإقامة حلف مضاد من قيادات مجتمعية وسياسية، وهم على استعداد للوقوف مع أي قوة تواجه ما يسمى بالحلف الصالحي - الحوثي، وذلك سيدخل البلاد في دوامة صراع وحروب أهلية، تكون المذهبية والطائفية هي عنوانها، وربما نصل إلى طريق التجربة السورية والعراقية إذا لم يتم إيقافها».
من جانبه، يرى الكاتب السياسي ياسين التميمي أن الأحداث التي شهدها اليمن وأعادت صياغة المشهد السياسي فيه، بدءا من دماج ومرورا بعمران وانتهاء بسقوط العاصمة صنعاء بيد الحوثيين، ليست إلا مشروعا تبناه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، بالتعاون مع الحوثيين، من أجل استعادة السلطة، عبر اللعب بالأوراق الخطرة وأخطرها الورقة المناطقية والطائفية.
ويقول التميمي لـ«الشرق الأوسط»: «التقدم العسكري الذي أحرزه الحوثيون كان بفضل التحاق مئات العناصر من الحرس الجمهوري المنحل الذي لا تزال وحداته المندمجة ضمن ألوية عسكرية جديدة، تدين بالولاء لقادتها السابقين من أبناء الرئيس وأقاربه والمحسوبين عليه، هذا بالإضافة إلى الأسلحة الحديثة والمتطورة»، مضيفا أن «حلف الثورة المضادة (صالح + الحوثيين)، يتمثل في 3 مستويات، الدعم العسكري، والدعم الإعلامي والدعم الاجتماعي، فعملية الاستقطاب الواسعة التي جرت في الأوساط القبلية برعاية صالح، عبر استخدام الحشد القبلي في حصار صنعاء وانضمامهم إلى حركة الاحتجاجات التي عبارة عن غطاء لمخطط الانقلاب على الدولة».
ويؤكد التميمي أن «مشروع استعادة السلطة كان واضحا في خطابات زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، الذي كان يظهر قدرا من الود تجاه حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه صالح، ويتبنى خطابا حادا تجاه خصوم صالح الذين أطاحوا به، وعلى رأسهم حزب الإصلاح واللواء علي محسن وغيرهم من القادة العسكريين والساسة الذين دعموا الثورة الشعبية، بالإضافة إلى مشايخ حاشد من آل الأحمر، الذين كانوا أهدافا للحرب الحوثية، التي هي الوسيلة المعتمدة في مشروع استعادة السلطة». وحذر التميمي من خطورة هذا التحالف على اليمن بين صالح والحوثيين لأنه «يستند إلى أسس مذهبية ومناطقية، سيكون من نتائجها إذكاء حرب أهلية وطائفية في اليمن، يصعب التكهن بمآلاتها».
* أطماع متجددة
* لقد جاء الحوثيون من بلدة مران في أقصى شمال اليمن إلى صنعاء مرورا بمدن الوسط والغرب، تحت لافتة حركة احتجاجية ضد الحكومة. لكن الكثير من اليمنيين يقرون بأن إمكانات وقوة الحوثيين لا تمكنهم من تحقيق ذلك، دون التحالف مع صالح. ويفسر المحلل السياسي الدكتور عبد الباقي شمسان ما يحدث باليمن بأنه تكرار لتجارب سابقة، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «بقراءة مقارنة بين اتفاقية التسوية بين الملكيين والجمهوريين في منتصف السبعينات من القرن السابق والتسوية الخليجية عام 2011، نجد أنه لا فرق بينهما، رغم الفارق الزمني، فنجد عودة الملكيين مقابل تجديد شرعية نظام صالح وعودته، ثم الاستفتاء على شكل الدولة مقابل إقامة حكومة مناصفة»، موضحا «تلك التسوية جعلت الحقل السياسي اليمني مضطرب حتى يومنا هذا، أما التسوية الثانية فلم تستفد من علم الانتقال الديمقراطي والتجارب الدولية التي تقتضي إجراء مصالحة مع الذاكرة الوطنية وانسحاب طوعا وجبرا لعدد من الفاعلين السياسيين من الحقل السياسي، خاصة إذا جاءت التسوية بعد احتراب». واعتبر أن «بعض البلدان الراعية اعتقدت أن كل خيوط اللعبة بيدها، فكانت تترك الحقل السياسي يتفاعل باستقلال محفوف بالمخاطر وانساق الجميع في مسار سياسي مضمون بمواد التسوية، لكن في الوقت نفسه استمر الصراع بمختلف الوسائل»، على رأسها المسلحة.
ويؤكد شمسان أن «عودة النظام السابق كان مخططا لها، من قبل صياغة التسوية التي كانت بداية لتجديد شرعية النظام السابق، وفي مرحلة ثانية تركت السلطة الانتقالية دون دعم، لكي تواجه الأزمات الاقتصادية والأمنية وعمال تخريب تمهيدا للانقضاض عليها». وتابع: «لم تكن الأطراف الراعية تدرك مقدار الاحتقان ونزوع العودة للسلطة ودرجة تشابك جماعات المصالح، والأهم من ذلك مدى توغل إيران في اليمن وتحالفاتها مع الجماعات المتصارعة التي تجمعت براغماتيا حول جملة من الأهداف المشتركة المتمثلة في تصفية الخصوم والعودة إلى السلطة بشكليها السلالي الإمامي والعائلي الصالحي». وينتقد شمسان بعض الدول التي كان لها ما وصفه بـ«قصر نظر» تجاه المخاطر التي تحدث في اليمن، إثر تسليم العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر، رغم ما بيده من قدرات مالية وتحالفات وإمكانات استخباراتية. ويقول إن كان على تلك دول «أن تراهن على الشعب اليمني وليس على أشخاص، أو جماعات». ولفت إلى أهمية اهتمام الدول الخليجية بما يدور في اليمن، قائلا: «اليمن هو عمقها الاستراتيجي، وعليها أن تفكر في كيف تحمي ذلك، وتتدخل بقوة فاعلة لإعادة الاستقرار إلى البلاد التي قد تنحدر إلى صراعات قد تمتد عقدين أو ثلاثة».